

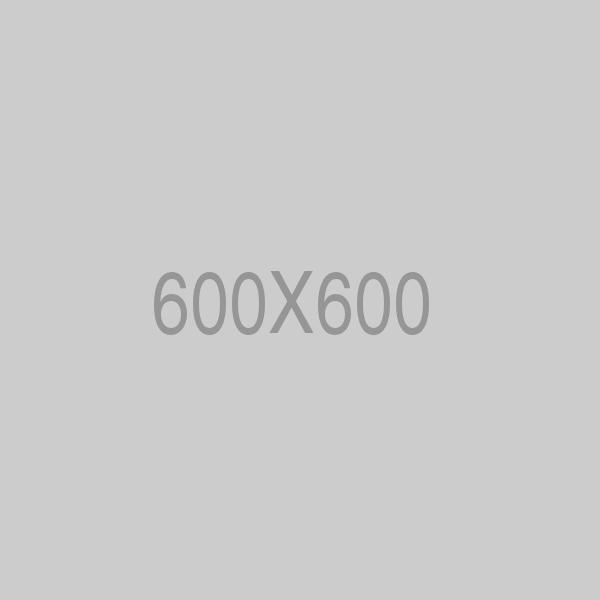
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين، وصلى
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين .. أما بعد:
تحدثنا
في لقائنا السابق عن بعض المقدمات المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل. فضلها
وثمراتها العظيمة والحث عليها وما جاء من النصوص حولها، ثم تحدثنا عن القواعد
الفقهية وتعريفها وموضوع هذا العلم وثمرته وأهميته شيء من التمييز بينه وبين غيره
من العلوم المقاربة له.
سنحاول
في محاضرتنا هذه وهي الثانية والأخيرة أن نطبق القواعد الفقهية الكبرى على ميدان
الدعوة إلى الله عز وجل. والمقصود بالقواعد الفقهية الكبرى تلك الخمس التي ذكر
جماعة من الفقهاء أن مدار الفقه عليها:
هذه
القواعد الخمس تقريبا التي يمكن أن نقول أن الفقهاء متفقون عليها. يختلفون في
تطبيقاتها، يختلفون في القواعد المتفرعة عنها، يختلفون في بعض الفروع هل تلحق بهذه
القاعدة أم بتلك؟ ولكنهم إجمالا لا يختلفون حولها. ثم هذه القضية الأولى وهي قضية
الاتفاق إجمالا حول هذه القواعد.
القضية
الثانية أن هذه القواعد يمكن أن يبنى الفقه كله عليها. أي يمكن أن تفرع من هذه
القواعد الكبرى من القواعد الفقهية التي هي أصغر منها. ومن هذه القواعد الفقهية
يمكن أن تفرع فروعا فقهية لا تتناهى. وسيأتينا بعض التمثيل لذلك ولا سبيل إلى الاحاطة
به لا في هذه المحاضرات ولا محاضرات متعددة؛ لأنه كما أقول لك مدار الفقه على هذه
القواعد. فيمكنك أن تفتح أي كتاب من كتب الفقه التي تعتني بالاستدلال العالي،
وتعتني بالنظر في القواعد والمقاصد ونحو ذلك. لا تلك المدونات الفقهية التي تنظر
إلى الفرع مستقلا عما يشبهه. فإذا فتحت مثل هذه الكتب العالية فإنك ستجد لهذه
القواعد حضورا في كل أو جل تلك الكتب بشكل أو بآخر من هاتين القضيتين فإن من
الممكن أن نكتفي بتطبيق هذه القواعد الكبرى على مجال الدعوة إلى الله عز وجل أو على
غيره من المجالات المختلفة، يمكننا أن نكتفي بذلك ونستغني به عن أن نتتبع القواعد
الفقهية كلها، وننظر في طريقة تطبيقها على تلك المجالات الدعوة أو غيرها. فإذا هذا
مسوغ قوي لما سنقبل عليه بإذن الله عز وجل في هذه ونسأل الله التيسير.
إذا نبدأ بالقاعدة الأولى
وهي الأمور بمقاصدها. هذه هي الصياغة المشهورة لهذه القاعدة. وهذه القاعدة مأخوذة
من حديث رسول الله صلى الله وعلى إله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
ما نوى). الحديث وهو ثابت في الصحيحين. إذا حين نقول الأمور بمقاصدها نقصد بذلك أن
جميع أعمال المكلفين. وجميع أقوالهم وتصرفاتهم عموما يختلف الحكم الشرعي فيها بحسب
اختلاف مقصود هذا المكلف. وغايته التي يصبوا إليها من وراء هذا الفعل أو هذا
القول. أي الحكم الشرعي يتغير بتغير النية، وكذلك ليس فقط الحكم الشرعي، ولكن
النتائج العملية التي تبنى على هذا الفعل، ونقصد بذلك النتائج العملية الشرعية،
النتائج التي تبنى عليه مبنية كذلك على قصد المكلف أي على نيته. وأنتم لا شك من
خلال معرفتكم بعدد لا بأس به من فروع الفقه تعرفون أن لهذه القاعدة تطبيقات لا
تحصى.
فمثلاً:
فعل القتل. شخص مكلف قتل آخر. فيمكن أن تكون صورة الفعل واحدة، ولكن يكون الفعل في
التوصيف الشرعي مختلفا جداً بسبب اختلاف القصد. فقد يكون القتل عمداً وقد يكون
خطأ. والذي ينبني على العمد ليس كالذي ينبني على الخطأ. أولاً من جهة الحكم الشرعي.
فقتل الخطأ إذا لم يكن صاحبه مقصرا فلا اثم عليه. القتل العام فيه الإثم العظيم.
كما لا يخفى. هذا الحكم من جهة هل هذا القتل حرام أو ليس حراما إلى غير ذلك. ثم
أيضا من جهة ما ينبني عليه، فالقتل العمد ما الذي ينبني عليه من جهة القصاص مثلا
أو من جهة الدية أو من جهة كذا وكذلك القتل الخطأ.
فإذا
هذا ما أشرت إليه بقولي إن اختلاف القصد ينبني عليه اختلاف في الحكم نفسه الحكم
الشرعي. وثانياً خلافٌ في ما الذي ينبني شرعا على ذلك الفعل.
نأخذ
فعلا آخر: مكلف أعطى مالاً لشخص آخر. الصورة واحدة لكن القصد يختلف فيختلف الحكم وما
ينبني عليه. يمكن أن يكون هذا الشخص قد قصد بذلك أن يهب هذا المال ذلك الشخص الآخر.
يمكن أن يكون قصده القرض؛ فحينئذ يجب على هذا الشخص الثاني أن القرض لصاحبه. يمكن
أن يقصد أنه يترك هذا المال عنده أمانة. وحينئذ فذلك الشخص عليه أن يرجع المال وهو
مؤتمن عليه وضامن له إن حصل تقصير فضاع إلى غير ذلك. فالصورة واحدة لكن اختلاف
المقصود ينبني عليه اختلاف كبير في الحكم والأثر.
كذلك
صورة الزواج مع النكاح مع السفاح. قد تكون الصورة واحدة. رجل مثلا يعطي مالاَ
لامرأة، ويمكن أن نفترض صوراَ، ويمكن أن نسعى إلى توحيد الصورة بين النكاح والسفاح
ولا يكون المغير للحكم والأثر سوى القصد. في أمثلة لا تحصى وتندرج تحت هذه القاعدة
الكبرى.
مثال
آخر: شخص التقط شيئا وجده في الشارع التقطه بنية أن يُعرف به فإذا جاء صاحبه رده
إليه. هذا لقطة جائزة. أخذه بنية أن يأخذه لنفسه. وأن لا ينشغل بتعريفٍ به ولا أي شيء.
يكون نوعاً من الغصب ومن السرقة.
ثم
هذه القاعدة الكبرى تنبني عليها قواعد كثيرة جدا فرعية، من ذلك قاعدة: العبرة في
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولها صيغ مختلفة. وهذا أمر مهم
جدا في العقود، وتطبيقاته كثيرة بحيث العبرة ليست فقط بما يقال بالألفاظ التي
تقال، ولكن بما يقصده القائل وما يقصده المتعاقدان. فهذا تضييق للقاعدة الكبرى إلى
مجال العقود.
كذلك
في الأيمان يذكرون قاعدة: اليمين على نية الحالف. وهنالك قواعد كثيرة جدا تندرج
تحت هذه القاعدة. مثلا: النية تعمم الخاصة وتخصص العامة. يمكن أن ترجع لمجلة
الأحكام العدلية أو إلى كتب الأشباه والنظائر وتبحث عن القواعد التي فيها لفظ
النية أو القصد أو المقاصد وما أشبه ذلك.
الان
ننظر ما التطبيقات الدعوية التي يمكن أن نجدها لهذه لقاعدة الأمور مقاصدها:
التطبيق الأول: أننا كنا قد ذكرنا من قبل
في تعريف الدعوة إلى الله أنها قربة، وعمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا
كانت الدعوة قربة وعبادة فلا بد فيها من نية لينال صاحبها الأجر. وهذا مهم جدا. فمن
يمارس الدعوة ظاهر الحال. ولكن ليست له نية بأن يكون فعله هذا يتقرب به إلى الله
عز وجل ونحو ذلك. فهذا لا يؤجر على فعله، وإن كان فعله في ذاته متعدياً إلى خلق من
الناس، ولذلك قد يوجد - والعياذ بالله تعالى - من العلماء أو من الدعاة من يكون
سبباً في دخول خلق من الناس إلى دين الله عز وجل، أو على الأقل إلى خروجهم من
المعصية إلى الطاعات، والتزامهم واستقامتهم على الدين الصحيح ولا ينال هو من أجر
ذلك وثوابه شيئا، بل والعياذ بالله تعالى قد يكون الأمر أخطر من ذلك قد يكون من
الذين تسعر بهم النار يوم القيامة! فلا بد من الإخلاص، والإخلاص يدخل في الأعمال
كلها، وكما لا يخفى عليكم أن من البديهيات المعروفة بالشرع أنه العمل لا يمكن أن يقبل
إلا بركنين كبيرين الإخلاص: أن يكونا خالصاً لوجه الله عز وجل. والصواب أن يكون
على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يهمنا هنا هو النية فلابد من
النية. إذا هذه مسألة في غاية الأهمية؛ لأن الكثيرين قد يغفلون عنها في خضم
عملهم الدعاوي. لأن العمل الدعوي بطبيعته تدخل فيه أشياء كثيرة
تتشابه مع أعمال أخرى ليست من قبيل العبادات. مثلا الدعوة فيها خطابة. إلقاء كلمات
لا يلزم أن يكون عبادة. فيمكن أن يلقي الكافر كلمة، ويمكن أن يخطب الفاجر خطبته.
الدعوة إلى الله عز وجل فيها الحوار. والحوار كذلك لا يلزم أن يكون عبادة وهكذا.
فمكونات الدعوة ليست خاصة بالعبادة وليست متمحضة في معنى التعبد. بخلاف الصلاة
مثلا فيها السجود الركوع الذكر هذه أشياء لا تكون إلا عبادات. فهي متمحضة
في العبادة. فبما أن الدعوة على هذه الصورة أي يمكن أن تجتمع وتشترك مع أمور أخرى
خارج دائرة العباد، بل قد تكون خارج الدين كله؛ لأجل ذلك فالعامل في مجال الدعوة
قد يغفل عن معنى كونها قربة يتقرب بها إلى الله فيغفل عن الإخلاص فيها لله سبحانه
وتعالى. قد لا يفكر إلا في كيف ألقى الكلمة. أو كيف أتكلم أمام الناس؟ كيف يظهر
كلامي بأنه مقبول؟ كيف أرضي الناس بكلامي؟ يكاد يفترق في ذلك أن خطيب التنمية
الذاتية أو التنمية البشرية وعلوم الطاقة ونحو ذلك الذي همه إرضاء الناس. لا ينبغي
أن يكون همك الأكبر إرضاء ربك سبحانه وتعالى. فإن جاء في ضمن ذلك إرضاء الناس فهو
نعمة. وإن كان إرضاء الناس لا يكون إلا بما يسخط رب العزة سبحانه وتعالى فلا حاجة
بنا إلى رضوان الناس. لو سخط الناس كلهم ورضي الله عز وجل فذلك هو المطلوب. هذه
معاني مهمة وبدهية لا أخبركم بشيء جديد لا تعرفونه، هذا من قبيل التذكير فقط. ولكن
مع كونه بديهيا معروفا عند الجميع. كثير من الناس لا أقول غالب الناس لكن من
المشتغلين بالدعوة ويدخل في هذا الدعوة بمعناها العام، الذين ينظمون الأعمال
الخيرية، الذين ينظمون محاضرات، الذين يشتغلون في مواقع التواصل، الذين ينشرون
الكلام الطيب ... إلى آخره. كل من يعمل في هذا المجال عليه أن يتفقد نيته بين
الفينة والأخرى. هذا التطبيق الأول.
التطبيق الثاني: على الداعية إلى الله عز
وجل أن يحذر أشد الحذر من أن يُظهر نفسه على حساب غيره من الدعاة.
بمعنى:
عليه أن يحذر من أن الشهوة خفية. نبه عليها كثير من أهل العلم، وخاصة المشتغلين في
مجالات السلوك. وهي: أنك حين تتكلم أو تكتب بطرف خفي لا يكاد يتفطن له إلا القلة
من الناس تظهر أن ما تقوله أنت صواب وعلم وعن كتب وسنة وفيه تأصيلات علمية رائقة
إلى غير ذلك. وأن من يخالف ربما قد لا تذكر اسمه لكيلا تتهم بأنك تطعن في فلان أو علان.
لكن من يخالف في هذا هؤلاء عندهم جهل، أو ضعف علمي أو خلل منهجي. بعبارة أخرى أنت تبني
دعوتك على أنقاض دعوة غيرك. الكلام ليس عن أن يكون هؤلاء هم من الضلال من المبتدعة
من الفجرة لا. كلامي عن أناس بينك وبينهم بعض الخلافات الاجتهادية. ولكن أنت من
حيث تشعر أو لا تشعر بأن هذه الأمور أمور القلوب باطنة جداً لا يكاد يتفطن لها إلا
من نقب عنها، من حيث تدري أو لا تدري أنت تطعن في الآخرين بقلة العلم وضعف العلم،
وتظهر نفسك بخلاف ذلك كي تُظهر نفسك على أنقاضهم.
وينبني
على هذا أن هنالك فرقاً جوهرياً بين النصيحة والتعيير. وقد تكلم العلماء قديماً في
هذا. فحين ترى الداعية الآخر مخطئا في شيء فلا بأس أن تنصحه، بل نصحك إياه مطلوب
شرعاً. (الدين النصيحة)،
ولكن أن تنتقل من هذه النصيحة الواجبة إلى التعيير المذموم بأن تعيره بالجهل. أو
أن تعيره باختلال العقيدة، أو أن تعيره بسوء المعرفة بالواقع .. إلى غير ذلك هذا
تعيير وليس نصحاً، وهذا التعيير إنما يأتي من الأصل الأول الذي ذكرته لك وهو في
الحقيقة لا تعيره لأجل التعيير؛ بل لأنك تستفيد من تعييره. وهذا يقع للكثيرين،
وللأسف هنالك من يقع له هذا ليس فقط مع المعاصرين له، بل مع المتقدمين عنه. وهذه آفة
أعظم. بمعنى أنه لا يحلو له أن يؤصل تأصيلاً علمياً أو دعوياً أو وعظياً إلا بأن
ينسف جهود من جاؤوا قبله. يقول لك: كل ما قرأته في الكتب انساه. وأقبِل على ما أقوله
لك. ما يقوله الوعاظ الآخرون جهالات، تعالى لأحدثك بالوعظ المحمود، ما يذكره لك
العلماء الآخرون إنما هو اختلال في العلم وفي المنهج، وخذ مني العلم على أصوله .. وهكذا.
وهذه مشكلة في النية. الأمور بمقاصدها.
بناء
على هذا المهم هو أن يظهر الحق سواء ظهر على لسان غيري من الدعاة أو ظهر على لساني
أنا. وقد ورد هذا في كلام الشافعي وغيره من أئمة السلف، لا يهمهم أن يظهر الحق على
لسانه أو لسان غيره، المهم هو أن يظهر الحق لديهم. وهذه مرتبة من الإخلاص عالية
جدا، ولكن هل فعلا هذا صحيح؟ ينبغي أن يقيد هذا بشيء وهو أن هداية الناس على يديك
مما ينبغي أن يتنافس فيه التنافس الشرعي المحمود. رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: "لأن يهدي الله على يديك رجلاً واحدا خير
من حمر النعم" فإذا ليس المقصود فقط أن يهتدي فلان من الناس لكن كونه
يهتدي على يديه هذا اجر عظيم جدا؛ لأنه لو اهتدى على يد غيرك لكان لغيرك الأجر ولم
يكن لك في ذلك عظيم أجر. إذا ينبغي أن نقيد هذا الأصل الذي ذكرناه بكون ذلك في
النية والقصد فقط، وإذا جاء الأمر إلى المنافسة الشرعية أنا اسعى إلى أن يهدى
الناس على يدي. ولي في ذلك مقصد مشروع؛ لأن في ذلك أجرا وثوابا عند الله عز
وجل. لكن إن كان هذا لا يتحقق إلا بأن يعني نسف الآخر وأهجمه وأطعن فيه وأعيره فلا!
يبقى
الأمر في هذا المبحث كله قلبي، ومن جهة الصورة الظاهرة الأمور جيدة كيفما فعلت،
لكن الذي يميز إنما الذي يميز هو الأصول القلبية.
من القضايا والتطبيقات المهمة لقاعدة الأمور بمقاصدها: قضية المال
في الدعوة:
هل
أحتاج إلى التذكير بأن المال عصب الدعوة إلى الله عز وجل. وأنه لا سبيل إلى إقامة
دعوة راشدة منتشرة قوية إلا بالمال. سواء الذي يأتي من جهة المحسنين الذين عني
يتبرعون بذلك لوجه الله عز وجل، أو المال يكون بطريقة أوقاف معينة، أو استثمارات
أو نحو ذلك. لكن في جميع الأحوال لا بد من المال. بل يمكن أن يقال أيضا لا إشكال في
أن يأخذ المتفرغ للدعوة أو لنشر العلم أن يأخذ شيئا من المال لنفسه. وهذا أصل فيه
كلام فقهي معروف، زفيه شيء من الخلاف، والقول المعتبر الذي لا ينبغي أن يفتى بغيره
خاصة في أزماننا هذه هو جواز ذلك؛ لأنه في الأزمنة السابقة كان هنالك شيء اسمه الأوقاف.
كانت الأوقاف دارة، وكان أهل الخير والإحسان يأتون فيقفون اوقافاً طائلة على العلماء
والمدرسين ومحفظي القرآن والوعاظ الذين يعظون في المجالس، على القائمين على مدرسة
من الشرعية، على كل مشتغل في مجال العلم والدعوة .. هذه الأوقاف هدمت في مرحلة
الاستعمار وما بعده، ولم يبق منها إلا الاسم والرسم، تجد بعض الوزارات تسمى وزارة
الأوقاف إنما تشتغل بالأوقاف القديمة أما أن يوجد وقف جديد هذا لا يكاد يوجد! حين
هدمت هذه الأوقاف العلماء والدعاة إلى الله عز وجل والدعوة كلها من الذي سيقوم بها،
إذا المال لا بد منه في الدعوة، ولكن الحذر من أن يكون المال غاية عند القائمين
بالشأن الدعوي. أي بدلاً من أن يكون وسيلة إلى إقامة صرح الدعوة إلى الله يصبح
غاية في ذاته؛ فيصبح هذا الذي في مجال الدعوة إنما يدخل إلى هذا المجال ليكتسب من
وراء ذلك مالاً. هذا إشكال ينبغي أن يحذر منه أشد الحذر. ما الذي يفرق بين هذا
وذاك؟ القصد النية؛ لذلك هذا يدخل في قاعدة بمقاصدها؛ لأن الذي يدخل إلى مجال
الدعوة ويأخذ أموالا وقد تكون أموالا طائلة. بل يأخذ منها شيئا لنفسه يعيش منه. وع
ذلك لا يكون قصده بالدخول إلى الدعوة إلا نفع المسلمين. والتقرب إلى الله عز وجل،
ويأخذ من المال ما يكفيه. هذا لا إشكال فيه، نفس الصورة لكن هذا الشخص قصده هو هذه
الأموال التي يحصلها، حينئذ ينتقل الحكم من الإباحة إلى التحريم. هذا بالنسبة
للمال.
قضية أخرى مهمة جداً في عصرنا. وهي الشهرة:
لأن
شهوة المال على أهميتها هنالك ما قد يكون أهم
منها في بعض الأحيان، وهو السطوة والجاه عند الناس ما يسمى في عصرنا الشهرة. وشهوة
الظهور مهمة جدا ومتحكمة في كثير من القلوب ولذلك قالوا قديما: شهوة الظهور تقسم الظهور.
أي: أن هذه الرغبة في الظهور أمام الآخرين والتبريز عليهم تقسم ظهر صاحبها والعياذ
بالله. ما قلناه في المال نقوله في الشهرة. قلنا المال لازم لكن يجب الحذر. نقول
الشهرة أيضاً لازمة أو على الأقل مطلوبة إلى حد ما، ولكن يجب الحذر. لمَ هي مطلوبة؟
لأنه لو خيرت بين أن يكون عندك من الذين يعرفونك مئة وأن يكون الذين يعرفونك ألف.
لو خيرت بينهما بالنظر إلى التأثير الدعوي لا بأي اعتبار آخر؛ لأنه يمكن
بالاعتبارات الأخرى أنا أقول أنا أفضل أن لا يعرفني أحد. لكن باعتبار التأثير
الدعوي أن يكون عندك ألف أفضل أن يكون عندك مليون من المتابعين ومن المعارف أفضل.
فبجهة التأثير الدعوي لا شك أن الشهور مطلوب ولذلك نحن نقول نعم الشهرة مطلوبة وهي
حسنة للداعية. ولكن مع الحذر لأنه إذا صرت إنما تدعو إلى الله عز وجل لأجل هذه الشهرة
فحينئذ لم تحقق شيئا من المقصود وانقلب الأمر عندك إلى ضده. وهذه راجعة إلى القصد
والنية وهي أشياء قلبية.
هنالك
بعض الإشارات التي يمكن أن تبرز على السطح فتدلك على أن القضية ليست بقصد حسن، وأنك
قصدك هو الشهرة. من بين الإشارات أن تتكلم فيما يرضي الجمهور. هذا للأسف كثير من
الدعاة يفعلونه. بالمصطلح الذي يستعمله المصريون "تطبطب" تدللهم لا
تغضبهم لا تسخطهم. يحرص أشد الحرص على رضاهم. فتثير من الموضوعات ما يتقبلونه،
وتتجنب من الموضوعات ما تخشى مغبته عليك أو على دعوتك. حينئذ أنت تسعى إلى الشهرة
لا إلى رضا الله. وهذه الشهرة في هذه الحالة مذمومة. وهذا شيء كان قبل مواقع
التواصل. كان بعض الدعاة يشتهرون اشتهارا بالغا لأنهم يرضون الجمهور بأقوالهم
بكلامهم بتمييعهم الفقهي، تساهلهم بنسبيتهم في الحق لا يوجد حق مطلق، وإنما كل شيء
حسن، والطوائف كلها جيدة، والمذاهب كلها حسنة، وافعل ما شئت، كل ما يمكنك أن تتصوره
من المحرمات الفقهية يمكن أن أنفي عنك فيها الحرج وهكذا. النتيجة يتابعهم الناس
بالملايين. كان هذا قبل مواقع التواصل. وأثمر للأسف نتائج خطيرة. لكن بعد مواقع
التوصل ازداد الأمر. لأن مواقع التواصل من خصوصياتها القدرة على الإحصاء
المباشر. أنت تعرف بشكل مباشر حين تقول الكلمة كم وافقك عليها، وكم عارضك، وهل
انتشرت .. وعندهم جهد خطير جدا في مجال الإحصاءات. هذا لم يكن متحققا قديما لأنك
تنتج الشريط السمعي فتنتظر شهورا لكي تعرف هل انتشر انتشارا جيدا أو لم ينتشر. الآن
ظهر عندنا جيل من الدعاة ممسوخي الهوية. لا أتكلم عن الهوية العامة لكن أتكلم عن
الهوية الدعوية. الداعية ينبغي أن تكون عنده مبادئ يرجع إليها ، تكون عنده أصول
وثوابت لا تتزعزع راسخة وإن كان الناس كلهم ضد مبادئه ويقول ما يعتقده حقا أم أخطأ
لا يهم. لكن أن تكون تميل مع رغبات الجماهير نعم. لذلك أنا كنت قد كتبت منشورا عن
الذين يسمون بالمؤثرين. يراد لهم أن يكونوا بديلا عن الدعاة إلى الله عز وجل. خاصة
أن كثيراً منهم عنده نوع استقامة والتزام وتدين ويقول لك الدعوة الجديدة هي هذه هو
ما يسمى بالمؤثرين. فقلت هؤلاء في الحقيقة عند التأمل في فعلهم هو ركوب الأمواج.
هؤلاء يركبون على موجة ما يريده الجموع.
ولذلك
حين يكون الأمر متعلقا بقضية يمكن أن تغضب الجمهور تجده لا يتكلم فيها. حين يريد
الجمهور موضوعا معينا فتجدهم يتكلمون وينشرون وكذا .. يرضون الجماهير، ويرضون
الحكام، يرضون أصحاب السلطة، قلَّ منهم من يقول الحق مطلقا ولو أدى به إلى أن يفقد
جمهوره. لذلك لا لا تكاد المواقع والتواصل تنبهه أو تبلغه عن صفحاتهم أو توقفها أو
غير ذلك. لأنهم في الحقيقة حريصون على تلك الشهرة أكثر من غيرها. وأنا في الحقيقة
لا أقول هذا فقط من مشاهدة بعيدة بل عرفت أناسا وجاءتني أخبار عن قوم وصل بهم
الاهتمام والاحتفاء بالشهرة، وبعدد المتابعات وعدد الإعجابات إلى مرتبة خطيرة جدا.
تشبه أن تكون من قبيل المرض النفسي.
من
التطبيقات أيضا إحسان الظن عند الخلافات بين الدعاة. والخلافات واردة لاختلاف
مشاربهم توجهاتهم مذاهبهم اجتهاداتهم؛ فيمكن أن يأتيك أن فلانا من الناس يخالفك في
كذا وأنت تخالفني. بل يمكن أن يقع بينكم ردود. لكن إذا كان قصدك وجه الله سبحانه
وتعالى فينبغي فيجب أن تحرص أشد الحرص على أن تحسن الظن بذلك الداعية. فإذا قال
قولا تأمل قوله واحمله على أحسن المحامل. وقل لعله ولو بتكلف. لا يهم التكلف فهو
في هذا المقام مطلوب. لعله أراد وقصد كذا. فأحسن الظن به لأن قصدي أن أرضي
الله سبحانه وتعالى، وقصد ذلك الداعية هو القصد نفسه أن يرضي الله سبحانه وتعالى.
فالأصل أن نتفق لا أن نفترق ونختلف.. وهكذا.
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك.
وهي
قاعدة مشهورة جدا وأدلتها كثيرة، من أدلتها:
حديث
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الإمام مسلم وغيره: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً
فأشكل عليه منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
الجمهور يأخذون من هذا الحديث: أن من كان على طهارة متيقنا من ذلك فإنه إن شك في
انتقاض طهارته فلا يعدل عن المتيقن منه إلى المشكوك فيه حتى يأتيه يقين في ذلك. لم؟
لأن القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. عندك يقين أنت تستمر عليه وتستصحبه وتبقى
على هذا الأصل إلى أن يأتي يقين مثله ليرفعه، أو على الأقل غلبة ظن لا أن يأتي شك،
فهذا الشك لا يعتد به. أما المالكية فهم يخالفون في هذا الحكم الفقهي، فعندهم من
نواقض الوضوء الشك. كما قال ابن عاشور ضمن نواقض الوضوء: والشك في الحدث كفر من
كفر. فإذا عندهم أن من كان على يقين طهارة وشك هل أحدث ام لا فإن هذا الشك ناقض
للوضوء فعليه أن يتوضأ. فهل معنى ذلك أنهم يخالفون في القاعدة" لا يخالفون في
القاعدة؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك مستقرة عند المالكية أيضا وإن خالفوا في هذا
التطبيق الفقهي.
لم؟
لأنهم يقولون الأصل في هذا الذي متيقنا من الطهارة. وشك في الحدث الأصل أن ذمته
كانت مشغولة بوجوب الصلاة. اليقين: أن الذمة مشغولة بوجوب الصلاة، فلا يمكن أن يرتفع
هذا الأصل إلا بيقين. وهذا اليقين هو طهارة متيقنة يمكن أن ننتقل من حالة الشك في
الصلاة إلى حالة وجودها.
بعبارة
أخرى: اليقين لا يزول بالشك هذا متفق عليه عند
المالكية وعند غيرهم. لكن عند المالكية يجعلون القضية ليست مرتبطة بالطهارة، وإنما
يجعلونها مرتبطة بالصلاة نفسها. فيقولون الأصل أن الصلاة واجبة عليه. فهي تبقى
واجبة عليك. ولا يرتفع هذا الوجوب إلا بأن تأتي بطهارة متيقنة، فلابد من أن تتطهر
لتسلم لك الصلاة. فجعلوا الكلام في قضايا اليقين والشك مرتبطا بالمشروط الذي هو
الصلاة لا بالشرط التي هي الطهارة.
بغض
النظر عن صحة تأصيل المالكية أو عدم صحته. هذه مسألة فقهية لا تهمنا، لكن الذي
يهمنا أنهم متفقون على هذه القاعدة.
إذا
تجاوزنا مثال الطهارة والصلاة فهناك أمثلة كثيرة جدا. ففي الديون. إذا جاء شخص وثبت
دين له على شخص آخر. الأصل هو بقاء هذا الدين. ولا يرتفع هذا الأصل إذا كنا شككنا
في وفائه بالدين. يعني نحن متيقنون من وجود الدين لكن نشك في كونه قد أداه. ماذا
نصنع؟ نبقى على الأصل على اليقين. فنقول: الدين باق. ويستعملها القضاة كثيرا في
المنازعات بين الناس: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، وهذا هذه إحدى
القواعد الفرعية المتفرعة على قاعدة
اليقين لا يزول بالشك. هذه الطريقة للتعبير عن هذه القاعدة.
أيضا
من القواعد المتفرعة قولهم: "ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين". هذه
صياغة أخرى.
من
ذلك قولهم: "الأصل براءة الذمة".
ومن
الأصول المعتبرة عند الأصوليين: الاستصحاب. وهو بقاء ما كان على ما كان. استصحاب
الأصل. استصحاب براءة الذمة. استصحاب البراءة الأصلية وهكذا قواعد الاستصحاب كلها راجعة
إلى هذا المعنى. وهو استصحاب المتيقن فيه والإبقاء على الشيء اليقيني الذي لا
يرتفع بمجرد الشك.
مثلا:
الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها.
في
النكاح قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم.
لا
عبرة بالتوهم.
لا
ينسب إلى ساكت قول.
الأصل
في الأشياء الإباحة. هذه عند الجمهور خلافا للمعتزلة.
إلى
ذلك قواعد كثيرة جدا .. الآن ننظر في بعض التطبيقات الدعوية.
من
التطبيقات: أنه إذا وجد الداعية شخصاً من أهل العلم والفضل والسابقة في الدعوة إلى
الله وفي استقامته ونشر العلم ونحو ذلك، فالأصل ثبوت عدالته. هذا يقين عندنا. ثم جاءنا
كلام في هذا الشخص وتكلم فيه واتهم بفسق وبفجور أو في ذمته المالية. الأصل عدم
تصديق ما يقال فيه، ووجوب ما يرد علينا من أقوال أو أفعال يفهم منها خلاف الأصل على
أحسن المحامل، واستعمال القاعدة التي ذكرها الذهبي وغيره من المترجمين من أهل
العدل: "إذا كان الماء قلتين
لم يحمل الخبث". اقتباسا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى:
الماء الكثير إذا بلغ قلتين لا تؤثر فيه النجاسة القليلة التي يمكن أن تقع فيه. فهذا
رجل عالم داعية أمضي عمره في الدعوة إلى الله حامل لكتاب الله مشتغل بالتأليف
مشتغل؛ فيأتيك أنه أخطأ في مسألة أو ارتكب محرما، ولو ثبت عندك بيقين فضلاً عن أن يكون
إنما هو شك، فلا تسقطه لأجل ذلك؛ لأن اليقين أن الرجل عدل، والشك أن عدالته
خرمت. هذه قاعدة مهمة جدا، وعلى أهميتها ووضوحها كثير من الناس يخطئون فيها خاصة
عند اختلاف المذاهب العقدية الفقهية أو نحو ذلك. أو تباعد الديار. في بعض الأحيان
كأن الغيبة صارت مباحة وهي من الكبائر، والجميع يعرفون أنها من أعظم المحرمات، وورد
فيها الشيء الكثير في كتاب الله عز وجل وفي السنة، ومع ذلك تجد في مواقع التواصل
خصوصا وفي غيرها: سمعت فلانا الفلاني العالم الداعية أنه فعل كذا وكذا، سبحان الله!
تهدر ذلك كله وتهدر اليقين وتبطل اليقين بهذا الشك وبقيل وقال.
هذا
يجرنا إلى وجوب إعمال فقه الموازنات عند الحكم على الأشخاص والهيئات والجماعات. من
حقك أن تنتقد كما تشاء، لكن هذا في النقد المخصوص. أما الحكم الإجمالي فلا بد من
موازنة بين الخير والشر. لا يمكن أن أفعل كما يفعل بعض الناس يسوي بين الجلاد
والضحية. يسوي بين المسلم المستقيم الذي أخطأ في اجتهاده، وبين الفاجر أو حتى
الكافر المسلط على ذلك المسلم. يسوي بينهما، كلهم مخطئون، كلهم في سلة واحدة، كلهم
هم الذين جروا علينا هذا كذا وكذا. هذا خطأ. لا بد من موازنة بين الخير والشر.
لابد من أن تعتبر ماضيه، تلك الجماعة أو هؤلاء الاشخاص لهم ماض في الدعوة، لهم
سابقة خير، لهم شيبة إسلام، منهم من شاب في الإسلام، منهم من أفنى عمره في تحفيظ أولاد
المسلمين القرآن، أو في تعليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لأنه اجتهد
في قضية فأخطأ تنسفه نسفا؟ كلا. لا يكون هكذا.
أيضاً:
الأصل في المسلم البراءة والسلامة والعدالة، والأعراض حفرة من حفر النار. لا أدري
كيف يستسهل الناس الكلام فيها اليوم.
قبل
سنوات صحافة العار وصحافة الفضائح عندنا تتبعت رجلا وامرأة من أهل الخير. وذكروهما
بأشياء، أن تقول الصحافة ذلك هذا جهدهم وهذا مبلغ تدينهم. ليس هذا الإشكال. الإشكال
في بعض المستقيمين الذين وجدوا الفرصة سانحة لأجل الاختلاف في الاجتهاد الفقهي، أو
المذهبي، أو الطائفي، أو السياسي أو غير ذلك فولغوا في الأعراض. هذي صعبة جدا، ويمكن
أن تنسف جهدك الدعوي كل ما أنت مقبل عليه؛ فبسهولة بالغة فعلوا كذا وفعلوا كذا .. ونحن
لأجل هذا كله بالحكم على الظاهر. والله يتولى السرائر. لم نؤمر بالتنقيب في قلوب
الناس وصدورهم. وإنما أمرنا بأن نحكم على ظواهر الناس، قد يكون الشخص منافقا يظهر
الخير وهو من أهل النفاق. نعم قد يكون. لم أؤمر بالتنقيب عن قلبه ولا سبيل إلى ذلك،
ولو أمرت به لكان ذلك من التكليف بما لا يطاق. لا يمكنني أن أعرف ما في قلوب
الناس. فأنا المطلوب مني أن أحكم على ظواهر الناس فقط. فاحكموا بالظاهر. إذا كان
الظاهر خيرا فهذا عندي يقين لا يزول بالشك. وهذا عندي أصل لا يرتفع، إلا أن يأتي
يقين يرفعه. يقين كالشمس في رابعة النهار. غير هذا لا الأصل أن هذا مسلم. الأصل أن
هذا مستقيم. الأصل أن هذه أخت متدينة ومستقيمة وفاضلة وهكذا.
ثالثاً: في إطار اليقين والشك:
في
زمننا صارت الأخبار كثيرة إلى درجة التخمة. ومن لم يأخذ الأمر بحزم وجد؛ فإن الأخبار
تغرقه، يضيع في زحمتها ويغرق في أمواج المجريات المتتالية المتتابعة ليل نهار. لكن
إذا حزمت نفسك يمكن أن تخرج من هذا كله ولا تغرق فيه. فلابد من التثبت في الأخبار.
ولا بد من الحذر من أخطار الإشاعات. كم من الأفكار الباطلة بنيت على أخبار زائفة
.. كم من الإشاعات تهدم بها بيوت، تنسف بها دعوات، يلحد بسببها أشخاص ينتكس من
أثرها أناس لم يكونوا راسخين في إيمانهم إلى غير ذلك فلا بد من الحذر.
وبطبيعة
الحال هنالك الذين يخترعون الإشاعة وهؤلاء كذبة لا كلام لنا معهم، لكن هناك الذين
لا يخترعونها وإنما أتوا من تتبعهم للأخبار. وكثرة تتبع الأخبار والحرص الكلام في
الأخبار يؤدي إلى الاشاعة ولا بد شئت أم أبيت. وهناك تجارب معروفة في هذا المجال
يمكن أن ترجعوا إليها. مثلاً: أنا أقول الخبر ويبقى خبراً. ثم أتولى كبره صوابا
كان أو خطأ. لكن حين يأتي مائة من الناس أو ألف كلهم ينقلون هذا الخبر، هل تظن
فعلا أنهم كلهم سينقلون الخبر كما قلته بالضبط ويوثقونه ويقولون قال فلان ويأتون
بذلك بالفاصلة أو بالنقطة وبدون تحريف؟ لا. سيتصرفون وسيروون بالمعنى وبحسب ما
فهموا مني. ألف وراءهم ألف وراءهم ألف تصبح إشاعة زائفة خطأ لا أصل لها.
وأنا
أتعجب من هذا الحرص عند الناس على نشر الخبر. هنالك قنوات معروفة تنشر الأخبار.
اتركهم وما تولوا يتحملون مسئوليات هذه الأخبار التي ينشرونها. أنت ولابد تأتي إلى
صفحتك على الفيسبوك لتقول قالوا كذا. فيأتي الاخر يأخذها منك على أنها مسلمة
والحال أنها ليست مسلمة قيل كذا قال صارت قيل صارت. والنتيجة: أن الخبر الأصلي
الصحيح يضيع اذا كان صحيحا في الأصل والذي يبقى تشوهات الخبر. وحرصكم معاشر الناس
على الخبر والبحث عنه والجد فيه ونشره هو الذي يؤدي بالناس إلى اختراع الأخبار ويؤدي
إلى الإشاعات.
هناك مسألة أخرى تقع للدعاة كثيراً: التوثيق العلمي للفكرة:
التثبت
من الحقائق وتوثيقها بشكل علمي إحصائي قبل جعلها فكرة دعوية تنشر في الناس. قلَّ
من يفعل ذلك.
لا
يخفى عليكم قضايا كوكب اليابان. دعاة وقعوا في مثل هذا. يأتي إلى قصة ما ندري هل
هي صحيحة أم لا؟ أو إحصاء قد يكون صحيحا. لا يوثق القضية بشكل علمي. ثم ماذا؟ في
كوكب اليابان يفعلون كذا وكذا. يعني القضية التي ربما فعلها واحد، أو اثنان، أو عشرة،
أو مئة من اليابانيين الذين يعدون بملايين. تصبح مضطردة عند اليابانيين. هكذا يفعل
الغربيون. لو كان هذا عندنا لفعلنا كذا. تعميمات لا أصل لها. وأنتجت أفكارا خطيرة
جداً أهلكت الوعي لدى خلق من الناس، وأصيبوا بإحباط. أو أصيبوا بكره للذات وجلب
للذات. أو أصيبوا برغبة عارمة في التخلص من هذه الامة التي هم فيها أمة التخلف هذه
أصيبوا بإعجاب وانبهار أمام الحضارة الغربية أو أمام اليابان أو أمام كوريا .. أصيبوا
بتشوهات فكرية خطيرة جدا بسبب هذا الخطاب الدعوي المبني على الشك في موضع اليقين.
عدم التثبت في الحقائق عدم توثيقها بشكل علمي.
من التطبيقات أيضا لقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك":
أن
الداعية يجب أن يعتمد في مجال الأحكام العقدية والفقهية على المتيقن فيه. أتكلم
هنا عن الداعية غير المتخصص الذي ليس عالما. العالم له كلام آخر. لكن أن الداعية
غير المتخصص يجب أن يعتمد على المتيقن فيه من الأحكام العقدية عند خطابه للعامة،
عند دعوته الموجهة للعامة. وأن يترك الخلافي المشكوك في صحته. نعم. إذا كان يدرس
طلبة يكلمهم على قدر مستوياتهم ومؤهلاتهم فيكلمهم بالخلاف وبالإجماع. لكن عندما
يدعو الناس لا يمكن أن تدعو الناس إلى الخلافيات، بل عليك أن تدعوهم إلى أصول
الدين الكبرى. أي إلى الأمور الوفاقية، إلى الأشياء اليقينية، في مجال العقيدة لا
معنى لأن تخوض مع العامة في تفصيلات عقدية لا تطلب منهم. ولا تدركها ولا
توصل إليها مداركهم. وإنما تكلمهم بما يستطيعونه، كما قال على رضي الله عنه: "حدثوا
الناس بما يطيقون أتحبون أن يكذب الله ورسوله"، هذه قاعدة عامة. حدث الناس
بالأصول الكبرى أصول الايمان والتوحيد. في الفقه من الأمور الفقهية الكبرى بأمور
الصلاة وكذا وكذا، لكن لا تأخذ معهم في التفاصيل التي لا يستطيعون فهمها وإدراكها وهذا
مجاله واسع جداً.
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير:
دليل
ذلك قول الله سبحانه وتعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185]،
في أدلة أخرى كثيرة من الكتاب ومن السنة.
القاعدة
تعني أن الأحكام التي يمكن يترتب على تطبيقها حرج على المكلف في نفسه أو في بدنه وماله؛
فإن الشريعة الغراء تخفف على المكلف في ذلك لكيلا يقع في إحراج ولا في عسر. بعبارة
أخرى: التيسير مقصود للشرع. فالتيسير مطلوب في الشرع ومقصود له. الأمثلة أكثر من
أن تحصى. مثلا رخص السفر وقصر الصلاة والفطر في الصيام واجب في السفر، والجمع بين
الصلاتين من يحتاج إلى ذلك. بل فقه الرخص كله داخل في معنى أن المشقة تجلب
التيسير.
هنالك
قواعد فرعية كثيرة متفرعة عن هذه القاعدة منها:
قاعدة
الضرورات تبيح المحظورات.
قاعدة:
إذا ضاق الأمر اتسع. إذا وجد في الأمر شيء من الضيق فإن الشرع يقصد إلى توسيعه.
هنالك
قاعدة فرعية تقيد ما ذكرناه وهو: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. هنالك أشياء هي
في الأصل محرمة ثم أبيحت على جهة الترخيص. فحينئذ لا ينبغي أن يتوسع المكلف فيها
حتى تتحول من رخصة الأصل فيها التضييق إلى عزيمة الأصل فيها التوسع. مثلا الغصة لا
يمكن أن تزول إلا بجرعة من الخمر. ما وجدت ماء ولا أي شيء إلا جرعة من الخمر فإنك
تسيغ الغصة بجرعة الخمر ولا تتوسع فتشرب القنينة كلها. هذا فعل أهل العربدة والسكر
والعياذ بالله .. وهكذا. فإذا الضرورة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
من
القواعد: ما جاز لعذر بطل بزواله. إذا كان هنالك شيء محرم وإنما جاز بعذر خاص فإنه
حين يزول العذر نرجع إلى الأصل.
قاعدة
أخرى: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.
التطبيقات الدعوية:
من
أعظم في هذا المجال: البعد عن التكلف والتنطع وتحميل الناس ما يشق عليهم أو ما
ينفرهم في دين الله عز وجل في الأحكام الشرعية التي يدعو الداعية إليها. أنت في
دعوتك لا تتكلف أن تثقل على الناس، وألا تأمرهم بالأشياء التي لا يستطيعونها أو يستطيعونها
بصعوبة بالغة أو بمشقة كبيرة. إياك والتنطع "هلك المتنطعون"، إياك والتكلف والغلو
في الدين. حتى لو فرضنا أنك عندك طبع يميل إلى ذلك فليكن تشددك في نفسك، وإن كان
التشدد في نفسه ليس مطلوباً لكن شدد على نفسك كما تشاء لا تشدد على الناس خاصة حين
تكون في مقام ينظر فيك إليه وتعد قدوة لست كغيرك من الناس، فحين تقول الكلمة يكون
لها وقع وأثر فلأجل ذلك لا تشدد على الناس ولا تكلفهم إلا ما كلفهم الله به، ومتى
وجدت سبيلاً إلى التيسير فيسر سبيلاً شرعيا، وقدوتك في ذلك الحبيب صلى الله عليه
وعلى وسلم، "ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما"، كما
تقول عائشة رضي الله عنها. أنت نفس الشيء في الدعوة إلى الله عز وجل إذا وجدت
سبيلين كلاهما شرعي أحدهما أيسر على المكلفين فهو الذي تسلكه. وهو الذي تدعو الناس
إليه. هذا في مضمون ما تدعو اليه.
هنالك
شيء آخر هو في أساليب الدعوة. ذكرنا آنفا أنها أسلوب ومضمون ينبغي أن يكون بعيداً
عن الغلو والتنطع والتشدد والتزمت، وكذلك الخطاب أي أساليب الدعوة المستعملة ينبغي
أن يكون فيها شيء من التيسير ما أمكن.
مثلا:
تأتي لدعوة صبيان أو مراهقين لم يألفوا أن يسمعوا محاضرة قط، أكثر ما يسمعونه مقطع
من خمس دقائق أو دقيقة أو دقيقتين، حتى إذا فاتت دقيقتين قالوا أطلت علينا ويسرع
لكي يكون الكلام سريعا ويفعل كل شيء لكي لا يستمع الكلام كله. إذا كان هؤلاء الذين
تدعوهم هم هكذا فينبغي أن تراعي ذلك. لا معنى لأن تأتي إليهم تجلبهم اليك
ثم تفرض عليهم محاضرة طويلة من ساعة أو أكثر. هذا لا يطيقونه وقطعا سينتقلون من
حال الاستماع إلى حال النوم ولو كانوا يفتحون أعينهم.
كنت
أتذكر أخا قبل نحو من عشرين سنة غفر الله له تزوج وكان عنده شيء من الحماس ويريد
أن يدعو زوجته فأثقل كاهلها بشكل خطير جدا في المجالات الدعوية. هذا وهما حديثا
عهد بزواج في الأسابيع الأولى. كل يوم يطلب منها أن تسمع محاضرة وتلخصها وأن تراجع
كذا من القرآن. خطأ هذا. وهكذا لا تثقل على الناس في الأساليب كما أنك عليك ألا تسلك
بهم أشد المسالك في المضامين.
تطبيق
ثالث: هو أن الأعذار إذا بطلت -كما ذكرنا في قاعدة فرعية- يجب الرجوع لأصل العزيمة،
وعدم الاستمرار على الترخص للتيسير.
مثلاَ:
بعض الدعاة يأخذ من بعض العلماء فرع فقهي ميسر فيستمر على بثه في الناس مطلقا حتى
يصبح هو الأصل. مع أن العذر الذي من أجله وجدت هذه الرخصة لم يعد موجودا. بطل هذا
العذر، فينبغي أن نرجع إلى أصل العزيمة. ولهذا أمثلة خاصة في بلاد الغرب. في
الفتاوى المعدة للمسلمين في الغرب يفعلون مثل هذا كثيرا. مثلا: في أيام الحادي عشر
من سبتمبر وقع تضييق شديد على بعض النساء في بعض البلاد الغربية وأجاز من أجاز
للمرأة في مثل هذه الظروف التي اشتدت فيها كراهية المسلمين أن تزيل حجابها .. إلى غير
ذلك. هذا العذر لم يعد موجوداً منذ زمن في بلاد الغرب فضلا عن غيرها. لكن البعض ما
يزال إلى الآن يلوك مثل هذه مثل هذه الفتاوى. ما يزال كلما وجد امرأة عندها شيء من
التردد في قضية الحجاب. قال إذا كان عندك صعوبات في الحجاب فيمكنك أن تزيليه .. وهكذا.
فهنا
تطبيقات كثيرة يجب الحذر منها لكيلا يقع الداعية في تمييع الدين.
من التطبيقات: أن نعلم أن الداعية إذا
واجه واقعا صعبا يحتاج إلى صبر وتدرج فهذه حالة مشقة دون شك. ولا تكاد توجد دعوة
اليوم إلا وهي تواجه مثل هذه المشقة. فهذه المشقة تستلزم تيسيرا لأن المشقة
تجليب التيسير. فلا بد إذا من التيسير لمواجهة هذه الحالة. والتيسير يكون بالتدرج
لأن الدعوة واجبة لأن الوصول إلى ذلك واجب. فنتدرج لكي نصل لأنه لا
يمكن الوصول إلى تلك الغاية إلا بهذا التدرج وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا من تطبيقات المشقة تجلب التيسير.
كذلك
حين يصطدم الداعية ببعض المعوقات التي لا يمكن أن يخلو منها طريق الدعوة إلى الله
عز وجل فواجب الداعية أن يسعى إلى مواجهة هذه العوائق بقدر جهده وطاقته، فما تيسر
له من ذلك فبها ونعمت وما عجز عنه فإنه يكون معذورا فيه ولا يعاتب على ذلك؛ لأن
المشقة تجلب التيسير.
القاعدة الكلية الرابعة: قاعدة الضرر يزال. أو: لا ضرر ولا ضرار:
ودليلها
الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
ومعنى
القاعدة: أن كل فعل فيه ضرر على المكلفين فإنه يكون حراما. وتنبني عليه كل نتائجه
من جهة العقوبة أو التعويض المالي وما أشبه ذلك. فالقاعدة تعني: تحريم كل نوع من أنواع
الضرر، ويشمل ذلك الدفع والرفع. أي: دفعه قبل وقوعه ورفعه إذا ما وقع.
وهذه قاعدة تتفرع عليها قواعد في غاية الأهمية. منها:
قاعدة:
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
ومنها:
القواعد المتعلقة بالمقارنة بين المفاسد والمصالح، كقاعدة: درأ المفاسد مقدم على
جلب المصالح.
وقاعدة:
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
وقاعدة:
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
وما
أشبه ذلك. فقواعد الضرر والمفاسد ومقارنتها بالمصالح هذه من أهم قواعد الشريعة دون
شك، بل هي نظرية متكاملة يمكن أن نتحدث عن نظرية الضرر في الفقه الإسلامي.
أما
التطبيقات الدعوية من أن تحصر ولا نحتاج إلى تفصيل كثير لنترك المجال لشيء من
المناقشة أو الأسئلة.
من
ذلك: أن الإضرار بالمسلمين حرام، فيدخل في هذا
الإضرار مطلق الأذية. كالكذب واغتياب المسلمين والافتراء عليهم والوشاية بهم عند
حاكم ظالم وإن تدثر جميع ذلك بدثار الدعوة إلى الله عز وجل، ومن الناس من
المنسوبين إلى الدعوة من يستحل بعض ذلك. ستجد بعضهم لا يجد إشكالا في أن يفتري على
خصمه في الحقل الدعوي، أو أن يغتابه، أو أن يشي به عند ظالم ويفرح بوقوع التسلط
والظلم عليه .. هذا كله حرام دون شك.
ثم
من التطبيقات الدعوية الكبرى: أن مصلحة الدعوة معتبرة، وفي الحقيقة هذه القضية
قضية كبيرة جداً لو أننا عقدنا محاضرة كاملة لهذه القضية وحدها لكان مناسباً أو ربما
ما كفى ذلك. لم؟ لأن الكلام عن مصلحة الدعوة، وهل تعتبر أو لا تعتبر، وما
مقدار اعتبارها إن اعتبرت؟ وما الذي ينبني على اعتبارها من مخالفة للنصوص، أو لبعضها،
أو لبعض الأحكام الشرعية ،أو ما أشبه ذلك؟ هذا مجال واسع جدا وما يزال الدعاة
والمشتغلون بالدعوة وخاصة في الجماعات الإسلامية ونحوها ما يزالون يناقشون هذه
الأمور منذ عقود أو منذ أكثر من أربعين سنة، وما تزال كثير من هذه القضايا لم تحسم.
فنحن
نقول على جهة الاختصار الشديد: اعتبار مصلحة الدعوة هذا شيء مقبول. فمصلحة الدعوة
معتبرة، ولكن كغيرها من المصارف لا بد من تقييد ذلك بقواعد المصالح والمفاسد. ومن
ضمن ذلك أننا حين نتكلم عن مصلحة الدعوة فإننا ننظر إلى المفاسد التي يمكن أن تجر إليها
ثم تقارن هذه المصالح بتلك المفاسد، وهذه المقارنة لا بد من أن يدخل فيها اعتبار
الدنيا والآخرة. وهذا من أهم الأمور. بمعنى أننا حين نتكلم عن المصلحة في الدعوة
أو في غيرها ليس المقصود بذلك مطلق المنفعة المادية كما قد يظنه بعض الناس، بل
المصلحة في شرع الله عز وجل تشمل إلى جانب المنافع المادية التي يمكن أن يحصلها
الناس منافع أخرى هي أولى بالاعتبار. كالمنافع الروحية ورضى الله عز وجل والآخرة وأن
الآخرة مقدمة على الدنيا في الاعتبار وما أشبه ذلك من المباحث. وهذا مبسوط في كلام
الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وكنت قد أشرت إلى هذا في دورة
المقاصد، فلا ارى أن أعيد الكلام فيه وهذه من الأشياء التي تحتاج إلى بسطي وإلى
استدلال ونقول عن الشاطبي وغيره لأن هذا الأمر مما يقع الاختلال فيه عند
كثير من المشتغلين في مجال المقاصد عموماً وتطبيق ذلك في مجالات الدعوة على جهة
الخصوص.
القاعدة الخامسة: قاعدة العادة محكمة:
ودليلها
قول ربنا سبحانه وتعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228].
ودليلها أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" لامرأة أبي
سفيان. فهذه من بين الأدلة النصية على أن العرف معتبر في الشرع.
ومعنى
القاعدة: أن العادة والعرف يعتبران من ضمن الأدلة التي يرجع إليها في الأمور الشرعية
التي ليس لها تحديد في النصوص، فكل ما ليس له حد واضح في النص فالمرجع فيه إلى العرف.
مثلاً:
نفقة الزوجة على زوجها واجبة، لكن ما مقدار هذه النفقة؟ النصوص الشرعية لم تحدد ذلك.
وما كان يصلح من نفقة في زمن النبوة أو زمن الخلافة الراشدة لا يصلح في عصرنا؛
لأن حاجات الناس المادية متجددة ومختلفة؛ فكيف نعرف الواجب الذي يجب على الزوج
على زوجته وكذلك في نفقته على أبنائه؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالعرف، فما جرى في عرف
الناس في عادتهم المضطردة يعمل به في مثل هذه المجالات التي ليس فيها تحديد في
النصوص الشرعية.
وكذلك
في بعض الأشياء التي تنبني عليها عقود معينة. مثلاً: حين يجري عرف الناس أو عادتهم
في التقابض مثلا في عقد البيع أو شروط معينة جرت عادتهم بها في عقودهم فهذه الأعراف
ما دامت لا تخالف الشرع وليس فيها غرر ولا إلى ربا ولا إلى أي شيء، وكانت معتادة
للناس، وداخلة ضمن أعرافهم فإنها تعد مثل الشروط التي يشترطها المتعاقدان فيما
بينهما. ولذلك ذكروا من ضمن القواعد المتفرعة هذه القاعدة الكبرى: "المعروف
عرفا كالمشروط شرطا". الذي يتعارف الناس عليه يشبه الشرط الذي يشترطونه في
عقودهم.
يدخل في هذا المجال قواعد كثيرة:
منها:
الحقيقة تترك بدلالة العادة.
ومنها:
قولهم الإشارة المعهودة كالبيان باللسان.
ومنها:
المعروف عرفا كالمشروط شرطاً.
ومنها:
المتعارف عليه بين التجار كالمشروط فيما بينهم ..إلى غير ذلك.
والعرف
معتبر عموما عند الفقهاء كلهم، لكن للمالكية مزيد عناية به، فمراعاة العرف من ضمن أدلة
المالكية المعتبرة ولهم في ذلك تفصيل وكلام ليس هذا موضعه.
ومما
يدل على هذا المعنى: أن من أعظم الأصول التي امتاز بها المالكية عن غيرهم عمل أهل
المدينة، وعمل اهل المدينة يرجع في جزء كبير منه إلى هذا المعنى، أي إلى معنى ما
تعارف الناس عليه في المدينة، وعملوا به في الزمن الذي كان قبل ما لك رحمه الله
تعالى حيث أولاد الصحابة وأئمة التابعين متوافرون بالمدينة، فهذا يرجع إلى معنى العرف.
واستمر هذا المعنى في المذهب المالكي حتى كثر عندهم الحديث عن ما يسمونه العمل
المخصوص في بلاد معينة وفي أقطار مشتهرة كالعمل في أهل فاس وعمل أهل قرطبة وعمل أهل
القيروان وما أشبه ذلك، فهذا كله يرجع إلى الأعراف حين يقال العمل، لا يقصد بذلك أنهم
يجعلون عمل الناس وعرفهم في مواجهة النصوص إنما في الأشياء التي لا نص فيها وليس
فيها مخالفة للشرع فيعمل بعمل الناس وأعرافهم.
تطبيق هذا له مجالات كثيرة من بينها:
قضية
تأثير اختلاف البيئة في الأساليب الدعوية. فمن الاختلالات العظيمة التي ينبغي الحذر
منها: أن تطرد أساليب دعوية صالحة في بيئة معينة إلى غيرها من الأمكنة. وكذلك في
المضامين الدعوية. فهنالك فتاوى وأحكام شرعية وأساليب في الخطاب يمكن أن تصلح في
هذا البلد الإسلامي ولا تصلح في بلد آخر. يمكن أن تصلح في بلاد الغرب ولا تصلح في
بلاد المسلمين أو العكس .. وهكذا. فهذا كله راجع إلى قضية العادة محكمة أي إلى اعتبار
العرف في الدعوة إلى الله عز وجل أسلوبا ومضمونا. وأيضاً يدخل في هذا المجال أنه إذا
تعارف الدعاة إلى الله عز وجل على طرق ومناهج وأساليب معينة في الدعوة؛ فإن ذلك
يكون مقبولا ما دام لا يخالف الشرع. فلا يقال من أين جئتم بهذا؟ هذا لم يكن في زمن
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يفعله الصحابة؟ هذا كغيره من الأعراف التي
يتعارف الناس عليها كما يتعارف التجار اليوم على أشياء ويتعارف المهندسون
على أشياء ويتعارف الأطباء على أشياء، يمكن أن يتعارف الدعاة على طرق ومناهج
وأساليب في الدعوة فتقبل منهم هذه العادة وتحكم فيما بينهم، ويقبل منهم هذا العرف،
ويصبح أصلا يمكن أن يؤخذ به ولا ينكر عليهم التزامهم به، وأمثلة ذلك في المجال
الدعوي كثيرة جداً وأنتم تعرفون ولا شك منها أمثلة ونماذج.
هذا
ما يمكن أن نقوله على جهة الاختصار الشديد جدا في تطبيق القواعد الفقهية الكبرى
على المجالات الدعوية المختلفة. ويمكن بطبيعة الحال تنقيح هذا الكلام وتحريره
وبسطه وذكر أدلته بما يجعله أكثر فائدة وأكثر تأثيراً، لكن بهذا القدر، ويكفي من
القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال.
وأقول
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.









اكتب مراجعة عامة