

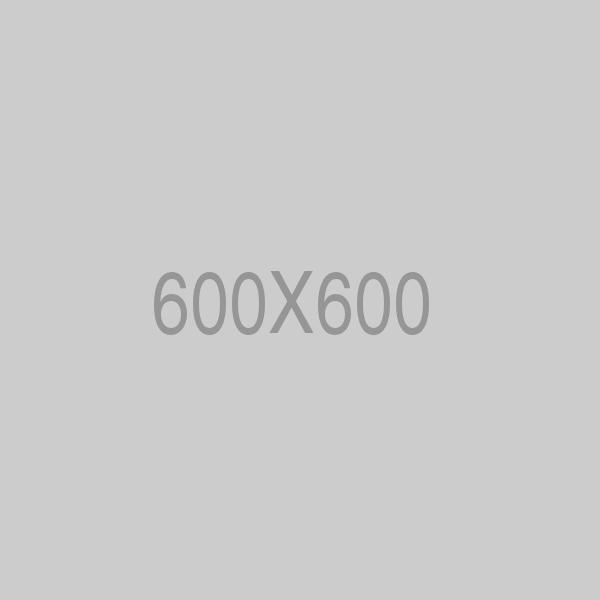
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين، وصلى
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين .. أما بعد:
فشكر
الله لكم معاشر القائمين على مبادرة الرواد الإلكترونية هذه الاستضافة، وأسأل الله
عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على الإفادة
والاستفادة، ولا شك أن هذا الموضوع الذي اخترتموه، وهو موضوع الدعوة في زمن الفتنة
هو موضوع عظيم القدر جداً؛ وذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الرسل، وهي
مهمة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا
نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {يَا
أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ} [المدثر:
1-2]، فأمره بالنذارة المتضمنة كذلك للبشارة من
باب إطلاق بعض المتقابلَيْن وإرادة مجموعهما، وهو أسلوب بلاغيٌّ معروف، والنذارة
والبشارة كلاهما لبُّ الدعوة إلى الله عز وجل.
وكلف
الله عز وجل بالدعوة الأمة كلها، كما قال سبحانه: {كُنْتُمْ
خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل
عمران:110]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم
محاور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه إذا مهمة كُلِّف بها سادة الخلق وهم الأنبياء
والرسل، وكُلِّفت بها الأمة كلها على جهة العموم والخصوص، فلا شك أنها مهمة عظيمة
في ذاتها، لكن تتأكد عظمة هذه الرسالة حين تَعْظُم الحاجة إليها كما في حالتنا في هذا
العصر، فالدعوة في كل زمان عظيمة القدر جدا، ولكنها في مثل زماننا هذا من أولى الأولويات،
ولذلك هذا التعبير "الدعوة في زمن الفتنة" مهم جداً، فهو مفيد لمَعْنَيَيْن
اثنين:
أولهما:
عظيم الحاجة إلى الدعوة: وإذا كان الزمن زمن فتنة وزمن صعوبات ومشاكل وبعد عن
الدين، فلا شك أن الدعوة حينئذ تعظم الحاجة إليها أكثر من الأزمنة الأخرى.
ولكن
أيضا يتضمن معنى آخر: وأن هذه الفتنة يمكن أن تصيب جسد الدعوة إلى الله أو أن تصيب
الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إذا هم لم يأخذوا بأسباب النجاة منها، فالمعنيان مرادان
فيما أحسب من مثل هذا العنوان. التنصيص على عظيم الحاجة إلى الدعوة إلى جانب
التحذير من وقوع دعوته في براثن الفتنة.
فنحن
نقول إذًا: الدعوة إلى الله عز وجل عظيمة جدا وعظيمة القدر ومُحتاج إليها، ولكن
نحتاج إلى ضبطها، وإذا احتجنا إلى ضبطها يأتي هذا المحور الأول الذي سأتحدث فيه
وهو: القواعد الفقهية المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل، الغرض منه بالدرجة الأولى
هو ضبط هذه الدعوة، لكي لا تنجرَّ إلى فتنة أو إلى مخالفة لمقصودها الأول، بحيث يفسد
الداعية من حيث يحسب أنه يصلح، وتنشر الدعوة تشوهات عقدية وفقهية ومنهجية وتربوية
من حيث تظن أنها على العكس من ذلك، تصلح الناس، وتبث فيهم الخير والهدى وما ينفع
الناس.
فإذن
كل مسلم في الحقيقة مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل، مكلف بذلك، خاصة أن كان يرى من
نفسه الأهلية لممارسة هذه الدعوة، وذلك بالعلم، بمعنى إذا كان عنده شيء من العلم، وشيء
من البصيرة؛ فإنه يكون مطالباً بالدعوة أكثر من غيره مع أن كل مسلم يمكنه أن يدعو
إلى الله عز وجل، فهنا تجاذبنا آية وحديث، الحديث قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (بلغوا
عني ولو آية)، والآية قول الله سبحانه وتعالى: {قُلْ
هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف:108]،
فالآية يستأنس بها في أن الدعوة لا تكون إلا
على بصيرة، وإن كانت الآية ليست صريحة في هذا الحصر الذي ذكرتُه .. الآية لا تدل
على ذلك بمنطوقها ولكن يستأنس بالآية في هذا المعنى، إذا يُحتاج إلى البصيرة ويُحتاج
إلى العلم في الدعوة إلى الله عز وجل.
ومن
جهة أخرى فإن الحديث يجعلنا مأمورين بأن نبلغ ولو آية، ولا شك أن كل مسلم يعلم آية
على الأقل أو حديثا على الأقل، أو حكما شرعيا عقديا أو فقهيا على الأقل، فإذًا كل
مسلم في الحقيقة يمكنه أن يدعو بل هو مطالب بهذه الدعوة إلى الله عز وجل.
نحتاج
في هذه المقدمات المتعلقة بالدعوة إلى أن نعرف حكم الله عز وجل في الدعوة، فقول
الله سبحانه وتعالى الذي تلوته عليكم آنفا: {كُنْتُمْ
خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ}، تدل
على أن الدعوة إلى الله عز وجل واجب كفائي، أي من فروض الكفاية، وفرض الكفاية كما
لا يخفى في علم أصول الفقه هو مهم يقصد حصوله بغض النظر عن فاعله، وهنالك تعريف آخر
هو المشهور على ألسنتنا هو: أن فرض الكفاية هو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن
الباقين. فحين نقول: هو مهم يقصد حصوله. أي: أن النظر في ذاته وليس النظر إلى المكلَّف
الذي يفعله، وهذا متحقق في الدعوة إلى الله عز وجل، ففي الحقيقة ليس المقصود في
الشرع أن يكون كل واحد من المسلمين داعية إلى الله، كما أن مثلاً من مقاصد الشرع
أن يكون كل مسلم مصليا يصلي لأن كل واحد مطالب بالصلاة، لكن الدعوة ليست كذلك، بل
المطلوب تحقق الدعوة بتحقق مقاصدها في الأمة، وهو:
إرشاد
الناس إلى الخير، وبيان سبيل الحق ليُتَّبع وسبيل الباطل ليُجتنب، والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر .. إلى غير ذلك من الأصول الجامعة التي تدخل في معنى الدعوة إلى الله
عز وجل، فإذا تحققت هذه الأصول فقد تحقق مراد الشرع، بغض النظر عن كون فلان من
الناس فاعل أو لم يفعل، فلو فرضنا جدلاً أن الدعوة إلى الله عز وجل قد تحققت في
عصرنا هذا، وتحقق مقصدها بثلة قليلة من الناس أو كثيرة، فحينئذٍ فغيره ممن لم
يمارس هذه الدعوة لا يحاسب ولا يطالب بذلك، فهذا أمر مهم علينا أن نفهمه، وعلينا
أن نقدر تنزيله في الواقع في واقعنا المعاصر، لأنه إذا قلنا بهذا فهل فعلا فرض
الكفاية هذا متحقق في عصرنا أم ليس متحققا، هل هذه الثلة الموجودة اليوم الذين
يسمون دعاة -بغض النظر عما يمكن أن ينتقدوا به أو يمدحوا به - هل يحققون المقصود أم
لا يحققون المقصود؟
لا
أظن عاقلا يقول أن الكفاية متحققة بهؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل، وهذا يقتضي أننا
نحتاج إلى مزيد من العناية بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يتحول
المسلمون من طابع السلبية المقيتة التي يعيش أكثرهم فيها إلى مقام الرسالية
المتحركة، بمعنى أن يكون كل مسلم رساليا أي صاحب رسالة، ومتحركا حركيا بطبعه يتحرك
لبث بس هذه الرسالة للأمة، لابد من هذين الركنين في كل المسلمين، بطبيعة الحال نحن
نعلم أننا وإن كنا نسعى إلى هذا فلا يمكننا تحقيقه، لكن إذا حققنا جزءاً وافراً
منه فقد أفلحنا بإذن الله عز وجل، بمعنى أنه نريد أن يكثر في المسلمين هؤلاء الرساليون
المتحركون لرسالتهم لبثها في الناس، لأننا حين ننظر إلى مقدار الصعوبات والعراقيل،
ومقدار القصف الإعلامي والفكري والثقافي والشبهاتي - أن صح هذا التعبير - الذي
يتعرض له حال الأمة حين ننظر إلى ذلك كله فإننا نجزم بأننا نحتاج إلى جهد كبير ولا
يمكن أن نستمر في حالتنا من الخمول والدعة والاستكانة والسلبية، في حين أن الآخرين
عندهم يعني جلد في بث فجوره.
بطبيعة
الحال الدعوة إلى الله عز وجل نحن نقول إنها واجبة كفائية، وأول المخاطبين بذلك هو
ولي أمر المسلمين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)،
ولقول ربنا سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ أن مَكَّنَّاهُمْ
فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} [الحج:41]،
فعلى هذا الإمام الذي مكنه الله عز وجل في الأرض مطالب بهذه الأمور: بإقامة الصلاة،
بإيتاء الزكاة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذًا بالدعوة إلى الله عز وجل،
فالمسؤولية الأولى إذا على هؤلاء الذين ولاهم الله أمر المسلمين، والمقصود بولاة
الأمور هنا ولاة الأمور من الأمراء من الناحية السياسية لا العلمية؛ لأنه كما لا
يخفى عليكم أولوا الأمر يطلق هذا المصطلح ويراد به الأمراء والعلماء، لكن العلماء
لا شك أنهم مخاطبون بالدعوة إلى الله هذا لا ينازع فيه أحد، لكن المشكلة أن ولاة
الأمور فرطوا تفريطا شنيعا في الدعوة إلى الله عز وجل بل بعضهم يمارس دعوة مضادة،
بمعنى بدلاً من أن يبث الخير يبث الشر، بدلا من أن يدعو إلى الله فإنه يدعو إلى سبيل
الشيطان، فهذا أيضا من الفتن الداخلة في العنوان "زمن الفتنة"، هذا من أعظم
الفتن التي أصيبت الأمة بها في عصرنا هذا، وبالتالي فإن المسؤولية تتأكد على آحاد
المسلمين، هي دائماً متأكدة في حقهم، ولكنها تزيد تأكيداً بسبب تفريط ولاة الأمور
أو أكثرهم في هذا الوجه، فإذًا لا يمكن تحقق هذا الواجب الكفائي إلا بجهد من آحاد
الأمة.
الدعوة
إلى الله عز وجل لا شك أنها - كما أسلفنا لها فضل عظيم جداً- هي مهمة الرسل والأنبياء،
ثم هي مهمة العلماء، والعلماء ورثة الانبياء كما تقرر في شرعنا، فحين كانت الدعوة
من مهام الرسل انتقلت هذه المهمة إلى ورثة الرسل وهم العلماء، في صحيح مسلم أن رسول
الله صلى الله عليه وعلى إله وسلم قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا
ينقص ذلك من اجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا
ينقص ذلك من آثامهم شيئاً). هذا يدلك على عظيم الدعوة إلى الله عز وجل،
نحتاج أن نركز هذه المعاني في أذهاننا ونتذكر بأننا إذا دعونا ملحداً إلى الإسلام أو
عاصيا إلى الطاعة أو مبتدعا إلى السنة فصار ذلك الملحد أو العاصي أو المبتدع صار
على خير. وصارع يؤدي واجباته، ويؤدي المطلوب منه شرعاً؛ فإن كل أجر يناله يكون
لذلك الداعية منه أعظم نصيب. وهذه المعاني مع بداهيتها في الشرع، وكون أغلب الناس
يعرفونها فهذا الحديث وغيره من معروف لدى الناس، ولكن مع ذلك الإشكال عندنا في طول
الأمد الذي يقسي القلوب فيجعلها لا تستشعر هذه المعاني عند العمل. أو لنقل أن القلب
الذي يصبح قاسياً يصبح غير قادر على التفاعل مع هذه المعاني، وأنت لاحظ هذا من نفسك،
مثلاً: في أوائل التزامك وتدينك واستقامتك حين تسمع هذا الحديث قد تكون تسمعه لأول
مرة. فإنك تحرص على الدعوة إلى الله وحين تدعو فلانا من الناس وتشعر باستجابة تفرح
لأنك تقول هذا الأجر سأنال مثله. ثم مرت بك الشهور والسنوات بعد ذلك قد تنشر الدعوة،
قد تبث ذلك في كل مكان .. تنشر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا
تكاد تستحضر هذه المعاني العظيمة.
وأنا
أعطيكم بعض الأمثلة: في مواقع التواصل الاجتماعي وهي من أعظم مجالات الدعوة إلى الله
عز وجل. صار يستعمل هذه أغلب الناس من المتدينين لا من غيرهم صاروا يستعملون مواقع
التواصل هذه للبحث عن الأخبار، والماجريات والمستجدات سياسية كانت أو كيف ما كانت وللجدالات
بين الطوائف والفرق. للضحك والدعابات والنكات والطرائف وما أشبه ذلك التي تفيد أو لا
تفيد، والجميع يريد أن يبث فكره الناس وإن كان فكراً غير قائم على أصول سليمة أصلاً،
لكن من منا لا يزال على تلك الطريقة القديمة التي كان عليها أوائل الدعاة إلى الله
عز وجل قبل عشرين سنة يذكِّر الناس بصيام الأيام الفاضلة، بكتب منشوره لأجل هذا فقط،
من منا يذكر الناس ببعض السنن والبدع، من منا يقتطف مقاطع دعوية أو علمية وينشرها
بين الناس، من منا يقرأ شيئا من القرآن ويبثه في الناس في مواقع التواصل، من منا
ينشر حديثاً وشرحه. هذه الاشياء التي صارت في عرف المعاصرين متجاوَزة، حتى صار بعضهم
يعني يستهزئ بهم، ويسميهم أصحاب مطويات. هذا كان في زمن ما قبل مواقع التواصل كانت
مثل هذه الامور تنشر في مطويات دعوية. صحيح أن هذه المطويات لا تصنع فقيها ولا
عالما لكننا دورها الدعوي الوعظي عظيم جداً. الذي يفعل هذا يعد متجاوزا قديما في
طريقة تفكيره وطريقة الدعوة، كأن هذه الطرق الحديثة أفضل، هذا غير صحيح، وربما سيأتي
هذا الكلام عند قضية التجديد في الدعوة إلى الله عز وجل في المضامين أو في
الاساليب.
فللأسف
الشديد السبب الحقيقي وراء هذا التقصير الدعوي مثلا في مواقع التواصل هو عدم
استشعار مثل هذه المعاني العظيمة الموجودة في هذه الأحاديث، في الحديث الآخر
الموجود في الصحيحين: (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النَعم)،
أو (من أن
يكون لك حمر النعم)، يعني خير لك من الثروات الهائلة. تصور القضية تصورا
صحيحاً، وانظر ما يقابل حمر النعم في ذلك العصر في عصرنا هذا من عقارات وسيارات واموال.
وتصور بعد ذلك، بل اعتقد اعتقادا جازما أنه أن يُهدى بك رجل واحد خير لك من هذا
المال كله. إذا استشعرت هذا المعنى هل يمكن أن تفرط في الدعوة إلى الله؟ لا يمكن.
لكن
إذا كنت يعني هذه الأحاديث تقرأها كأنك تقرأ اي كلام يقال لا تستشعر هيبة لمقام
قائلها وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا لعظيم ما فيها من الوعد. والأجر
والثواب ولا لما ما تعلمه من حرص قائلها على النفع على نفع المسلمين؛ لأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على أنه لا يقول لك شيئا إلا وفيه النفع
العظيم لك وللأمة كلها، إذا استحضرت هذه المعاني تتغير نظرتك إلى قضية الدعوة إلى الله
سبحانه. أنا فقط انا أريد أن أذكر بهذا حتى لا نسقط في الجفاف التربوي الذي وقع
فيه الكثيرون قبلنا. حتى صرنا للأسف الشديد نتعامل مع موضوعات شرعية تنطلق من
القلوب لتصل إلى القلوب نتعامل معها على أنها قضايا فكرية عقلية ذهنية جافة، كما
نتعامل مع الفيزياء أو الرياضيات قواعد أصول ضوابط أحكام .. إلى غير ذلك، هذا مهم
لا شك في ذلك، لكن لا ينبغي أن ننسى الأصل نحن هنا لسنا في درس الرياضيات أو فيزياء
أو علم من العلوم الكونية الحديثة، وإنما نحن في مقام دعوي علمي تربوي هذا هو الأصل،
والدعوة لا تنجح إلا إذا خرجت من قلب معتقد للكلام الذي يخرج على اللسان، أما إذا
وقع الفصام السيئ القبيح بين اللسان والقلب؛ فإنما هي كلمات تخرج من اللسان فتستقر
في الآذان لا أقل ولا أكثر، لكن حين تكون هذه الكلمات التي يطلقها اللسان منطلقة
ابتداء من القلب، فإنها حين تخرج من اللسان تستقر في قلوب المخاطبين بها، هذا الذي
نحتاج إليه نحتاج إلى دعوة ربانية، نحتاج إلى دعوة مربية، نحتاج إلى دعوة تزكى بها
النفوس وتشفى بها القلوب من أمراضها، وتنصلح بها مُهج الناس. لا إلى مجرد معلومات
نلقنها ونتلقنها، لا إلى مجرد قواعد عامة وأصول عامة نضعها ثم نناقش حولها ونجادل
حولها لكن لا نستشعر شيئاً من أثرها القلبي العظيم.
بعد
هذا أقول:
هنالك
أصول كثيرة جداً مؤسسة للدعوة إلى الله سبحانه، وليس من غرضي ألبتة أن أذكر هذه
الأصول كلها؛ لأن الكلام ليس عن الدعوة وإنما عن القواعد الفقهية المتعلقة بالدعوة.
فإذًا سأذكر من هذه الأصول ما يمكن أن يكون منطلَقا لموضوعنا الأساس الذي هو "القواعد
الفقهية المتعلقة بالدعوة".
الأصل
الاول الذي لا ينبغي أن نغفل عنه هو: أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قربة وعبادة
- عبادة بالمعنى العام لا بالمعنى النسكي الخاص - فإذا كانت قربة يتقرب بها إلى الله
سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنها منطلقة من الشريعة، وإذا كانت منطلقة من الشريعة فلا
يمكن أن تتفلت من قيود الشريعة. فكل ممارسة دعوية لا بد أن تنطلق من أصول الشريعة
وقواعدها وضوابطها الإجمالية، ولا يمكن أن نتصور دعوة على غير ما يقتضيه الشرع،
على غير ما يرضاه ربنا سبحانه وتعالى، على غير ما يرتضيه لنا ديننا الحنيف، كما
أننا لا نتصور ذلك في أية عبادة من العبادات. إذن هنا نصل إلى قناعة لا بد منها
وهي: أن الدعوة يجب أن تكون منضبطة بالشرع، ومعنى ذلك أننا نحتاج إلى طريقة بالضبط
كيف نضبطها. هذا سيجرنا إلى قضية القواعد الفقهية.
الأصل
الثاني: أن كثيراً من الممارسات الدعوية هي ممارسات اجتهادية. أي: منطلقة بالطبع
من الشرع كما ذكرنا في الأصل الأول، ولكن خاضعة لمعاني الاجتهاد، وحين نقول إنها
اجتهادية معنى ذلك أنها قابلة للأخذ والرد للمناقشة للتمحيص للبحث فيها للمراجعة، لأن
يزاد فيها وأن ينقص منها. لا يوجد في هذه الممارسات الدعوية الاجتهادية ما هو من قبيل
ما يشبه الوحي المنزل من السماء. وإنما ما دامت ممارسات اجتهادية فهي قابلة لما ذكرته
لك من قبل. بطبيعة الحال هنالك ثوابت لا يمكن أن لا ينازع فيها مسلم لكن كلامي عن
الممارسة العملية للدعوة إلى الله عز وجل، هذه الممارسة العملية في أغلبها هي أمور
اجتهادية، وإذا كانت اجتهادية نحن نعرف أن الاجتهاد له ركنان. لا يقوم اجتهاد إلا
بمعرفة بالشرع ومعرفة بالواقع. فهذه الممارسة الدعوية الاجتهادية تنطلق في إقرار
قواعدها وأصولها من الشرع والواقع أيضا. وإذا كانت تنطلق من الواقع على الأقل في
جزء تصوري منها فإن ذلك يقتضي أنها تخضع لمعرفة البيئة التي البيئة الدعوية التي
تعمل فيها، فمعرفة وتحديد البيئة الدعوية مهم جداً في تحديد نوعية الممارسات الدعوية.
وينبني
على هذا أن الممارسة الدعوية يمكن أن تتغير بعض أصولها التي ليست من قبيل الثوابت
حين تتغير البيئة، ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل في دولة من الدول الإسلامية
مثلا ليست الدعوة إلى الله عز وجل في دول الغرب، حتى داخل دول العالم الإسلامي
البلدان مختلفة جدا في مقدار تقبلها أو رفضها لهذه الأصول الدعوية في مقدار ما
فيها من تضييق أو تيسير أو غير ذلك هذا لا يخفى عليك. هذا الأصل الثاني.
الأصل
الثالث: أن الدعوة. لا تكون الا بعلم كما ذكرت لك آنفا: {قُلْ
هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ
اتَّبَعَنِي} [يوسف:108]،
أي: على علم. فإذا كانت الدعوة لا تكون إلا بعلم فما هذا العلم الذي ينبغي أن نستند
إليه فيه إقامة منار الدعوة؟ هو العلم الشرعي. وإذا أردنا أن يكون العلم الشرعي هو
الحاكم في الدعوة إلى الله عز وجل فلا بد إذاً من تأصيل وضبط وتقعيد لهذه الدعوة
إلى الله، هذا التقعيد من أين نأخذه؟ إذا قلنا بأنه تقعيد ننطلق فيه لنصل إلى نتيجة
أن الممارسة الفلانية حلال، الممارسة العلنية حرام. ما الذي يوصلنا إلى معرفة
الحلال والحرام إنما هو الفقه.
أولاً: تأصيل وتقعيد.
وثانياً: أن يكون هذا التأصيل والتقعيد في مجال الحلال والحرام لتكون النتيجة هي
حلال وحرام. إذاً نحتاج إلى القواعد الفقهية لكي تكون دعوتنا إلى الله عز وجل على
بصيرة. هذا الأصل الثالث.
الأصل الرابع: أن الدعوة فيها
مضمون وأسلوب. مضمون أي الشيء الذي ندعو له مثلا مجموعة من العقائد مجموعة من الأحكام
الشرعية. يعني ندعو الناس إليها. قد يكون هذا الذي ندعو الناس إليه هو الإسلام كله
لو قلنا إننا ندعو كافراً للإسلام، وقد يكون جزءا من الإسلام إذا كنا ندعو مسلماً
عنده تقصير في هذا الجزء .. هذا هو المضمون.
ثم هنالك الأسلوب. وهو كيف أوصل
هذا المضمون إلى هذا الشخص الذي أدعوه إلى الله عز وجل. هذه القضية متفق عليها. الإشكال
الكبير هو أنه يمكن أن يقع التباس بين المضمون والأسلوب. أن يقع خلط بينهما سواء
في جهات التضييق، أو في جهات الانفتاح.
مثال ذلك: لا أحد ينازع في
أن الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أسلوب دعوي
ليس متعلقاً بالمضمون. لكن إذا فهمت أن الحكمة تعني أن تتنازل عن بعض الشرع، وأن
تبيح بعض المحرم، وأن تزين للناس ركوب بعض البدع؛ لأنك تسمي ذلك كله حكمة وموعظة حسنة،
هنا تطرق الالتباس بين الأسلوب والمضمون؛ لأنك من أجل خدمة الأسلوب انتقلت إلى التنازل
عن المضمون أو تمييع أو تحريف المضمون. هذا إشكال كبير جداً يقع فيه الكثيرون.
وينبغي أن تكون مستحضراً للتفريق بين هذين فالمضمون لا ينبغي أن يتأثر بالأسلوب،
لا ينبغي أن نُغير في شرع الله عز وجل أو أن نحرف شيئا في شرائع الدين وأحكامه لا لشيء
إلا لنحقق أسلوب موافقاً لبيئة دعوية معينة، موافقا لمدعوين معينين.
هذا الالتباس بين المضمون
والأسلوب سببه الأكبر أن الأسلوب منفتح على كثير من ألوان التجديد. هذه طبيعته،
ونحن لا ننازع في هذا. الأساليب الدعوية التي نستعملها الآن كموقع الكتروني نتحاور
من خلاله، وأن نستعمل مواقع التواصل وأن نعمل بثا مباشراً هذه أساليب والتجديد فيها
كبيرا جدا، والأساليب بطبيعتها متفتحة على معاني التجديد، وإذا وقع هذا الالتباس
ومع عملية التأثير والتأثر بين الأسلوب والمضمون، وكان الأسلوب منفتحا على التجديد
كيف يمكنني أن أضبط التجديد في الأسلوب بحيث لا يؤثر على المضمون تحريفا أو تنازلاً
عن بعض الثوابت فيه. هذا من أعظم الإشكالات التًي يقع فيها الكثير من الدعاة! ليس
بالضرورة في مجال التميع، أو التيسير غير المنضبط، ولكن أيضا في مجال الغلو
والتشديد والتزمت في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني في طرفي النقيض يوجد هذا الإشكال.
فبعضهم قد يشدد في الأساليب الدعوية، والأساليب الدعوية توقيفية وكذا وكذا. فنتيجة
ذلك أنه بالضرورة يقع في تشديد فيما جاء في المضمون والعكس هو الذي ذكرته لكم آنفا.
فإذن وصلنا إلى نتيجة أننا محتاجون
إلى ضبط الأساليب كي لا يقع التأثير على المضمون، كيف يضبط ذلك؟ بالقواعد الفقهية.
فالقواعد الفقهية هي التي ستفيدنا في هذا الضغط لكيلا تتحول الدعوة إلى الله إلى كلأ
المستباح يمكن لكل أحد أن يركبه ويفعل فيه ما يشاء كما نشاهد اليوم في زمن الفتنة
هذا؛ فإن الكثيرين ممن يسمون دعاة يفسدون أكثر مما يصلحون للأسف الشديد.
ملخص القضية:
أننا نحتاج إلى ربط القضايا الدعوية بالقواعد الفقهية الأصولية؛ لأننا نحتاج إلى التأصيل
الشرعي لكثير من القضايا الدعوية خاصة في هذا العصر الذي ظهرت فيه اجتهادات - نسميها
اجتهادات تنزلاً - كثيرة عند قسط من الدعاة إلى الله. فهذه الاجتهادات فيها إشكالات
شرعية، فيها توسع مذموم، فيها انفتاح مرضي على جميع ما يقوله الغربيون، مثلا دخول
كثير من الأفكار من التنمية البشرية، بل دخلت قضايا الطاقة والجذب إلى بعض
الخطابات الدعوية المعاصرة، دخلت الأفكار النسوية مثلا إلى بعض الخطابات الدعوية
المتعلقة بالمرأة، دخلت خطابات الحرية والعلمانية إلى بعض الخطاب الدعوي؛ بحيث صار
خطاباً يساير المزاج العصري فيتحدث عن الحرية أكثر مما يتحدث عن القيود الشرعية
والضوابط الشرعية .. إلى غير ذلك.
إذن
هذه الاجتهادات كلها تحتاج إلى ضبط، والذي يضبطها هو القواعد الفقهية التي توفر المادة
الملائمة للاستدلال والتنطير والتقعيد.
فإذن الذي نسعى إليه هو هذا
الرباط الشرعي المتين المنضبط الذي يكون للدعاة إلى الله عز وجل متكأ مستنداً شرعياً،
ومرجعية يرجعون إليها. هذا هو حقيقة الإشكال الجميع يقول نحن نريد الالتزام بالشرع،
ونحن ننطلق من الدين. ولكن نحتاج إلى مرجعية يمكن الرجوع إليها وتكون واضحة.
من أهم كتب القواعد الفقهية
في العصور المتأخرة ما يسمى بمجلة الأحكام العدلية التي كانت في الدولة العثمانية،
وهي طريقة لوضع قواعد الفقه الإسلامي على شكل قوانين بالطريقة العصرية. ما فائدة
ذلك؟ فائدته أن القاضي الذي يريد أن يقضي في المحاكم لا يحتاج إلى أن ينظر في
المتون الفقهية وأن يراجع محفوظاته، بل يجد أمامه بنوداً مقننة فيها القواعد
الفقهية. هذا ليس موضوعنا لكن الموضوع هو أن هذه المرجعية مهمة جدا، حين يكون لدى
الداعية إلى الله عز وجل إلمام بالقواعد الفقهية عموماً، أو على الأقل بالقواعد
الفقهية الخمس الكبرى التي اتفق عليها الفقهاء؛ حين يكون عنده المام بهذه القواعد
وإلمام بتطبيقاتها وطريقة تطبيقها، وتكون عنده معرفة كافية بالقواعد المتفرعة عن
هذه القواعد الكبرى والضوابط - الضوابط خاصة بباب واحد، والقواعد تكون في أبواب فقهية
مختلفة - وإذا كان عنده إلمام أيضا بالضوابط المتفرعة عن هذه القواعد هذا كله يكون
له مرجعية. تتبين له بها التصرفات الدعوية المنحرفة، ويمكنه أن يضبط تحركه هو كداعية
وتحرك غيره من الدعاة، لأن في هذا المجال هنالك غلبة الهوى أو الجهل، أو الرغبة في
التقرب إلى المدعوين. هذا إشكال كبير جداً خاصة في عصرنا هذا حين تجد الداعية
يتنازل لأنه لا لهوى في نفسه ولا لجهله، هو يعرف الحكم الشرعي لكن مشكلته أنه يريد
أن يرضي المتابعين، خاصة من اصحاب الجماهير الكثيرة من المتابعين، يريد أن يرضيهم،
يريد يجذبهم إلى دين الله عز وجل، فيقع في تنازلات خطيرة جداً. كيف يضبط هذا؟
بالقواعد الفقهية.
ملخص ما ذكرناه هو:
هذه النتيجة الأخيرة أننا نحتاج إلى القواعد الفقهية لضبط الممارسات الدعوية.
قبل أن نتحدث عن تطبيقات
القواعد الفقهية في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، أحب أن أتحدث عن القواعد الفقهية
وتعريفها ومجال عملها إلى غير ذلك المباحث التي يمكن أن نذكرها باختصار شديد؛ لأنه
ليس من غرضنا أن نفصل في هذه الأمور؛ لأن هذه ليست دورة في القواعد الفقهية.
أولاً: القاعدة في اللغة هي
الأساس. فتقول قاعدة البناء أساسه. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة:127].
القاعدة في الاصطلاح هي
بمعنى الضابط. صحيح أن الضابط والقاعدة في الاصطلاح الخاص بالقواعد الفقهية بينهما
فرق، لكن عموماً القاعدة هي الضابط أي هي أمر كلي منطبق
على جميع جزئيات. قضية كلية تدخل تحتها جزئيات كثيرة وتحيط
بفروع ومسائل من أبواب متفرقة.
حين نقول: الأمور بمقاصدها.
هذه قاعدة فقهية هي ضمن القاعدة الفقهية الخمس الكبرى. يدخل تحتها ما لا يحصى من الفروع
الجزئية، ولا يختص ذلك بباب. فتجدها في الصلاة والصيام والحج، كما تجدها في
المعاملات المالية وفقه الأسرة وغير ذلك. ثم هذه القاعدة في الحقيقة إما أن تطبق
على جميع الفروع التي تندرج تحتها، وإما أن تشمل أغلب الجزئيات أو أكثر الجزئيات
الداخلة تحتها، ثم تجد أن هنالك جزئيات وفروعاً خارجة عنها وتعتبر استثناءات، وحين
تعتبر استثناءات معنى ذلك أنها تطبق عليها قاعدة أخرى تخرجها من هذه القاعدة وتجعلها
ملتحقة بقاعدة أخرى. على كل حال هنالك من ينازع في هذه الكلية ويقول لا بل الأولى
أن نقول حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئية لا على جميع الجزئية. على كل حال لا أحد
ينازع في أن القواعد هي تكون أغلبية، حتى لو قلنا في التعريف هي قضية كلية. فإنما
نقول ذلك لأن الأصل فيها أن تكون كذلك.
فخروج بعض الفروع لا يؤثر ولا يضر. بل الأصل هو هذا ثم هناك استثناءات
والاستثناء لا يغير من حقيقة الأصل ولا المبدأ. فإذًا هذه القواعد وإن كانت بحيث إذا
انفردت فإنه يوجد فيها بعض المستثنيات لكن مع ذلك لا تختل كليتها، ولا ينتقد
عمومها من حيث المجموع مع وجود هذه الاستثناء. هذا تعريف القاعدة الفقهية.
ما فائدة دراسة القواعد
الفقهية؟ وما فائدة هذا التقعيد الفقهي؟
الفائدة العظمى هي التيسير
في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها. فحين أعرف الفروع الفقهية. يعني
لنفرض أنني ضبطت كتابا من كتب الفقه
فأنا اعرف الفروع. في المسألة الفلانية الحكم الشرعي كذا
وكذا. فروع كثيرة في المعاملات العبادات إلى اخره. حين تأتيني واقعة حادثة ليس
فيها نص احتاج إلى الاجتهاد. حين أكون ضابطا للفقه عن طريق قواعده فإن ذلك يعينني
على ألحاق هذه الواقعة المستجدة بنظائرها وأشباهها من الفروع الفقهية التي أعرف
حكمها. لذلك من أسماء القواعد الفقهية الأشباه والنظائر، فإذًا تعينك كالقواعد على
معرفة أحكام القواعد الوقائع الحادثة وإن كنا لا نقول بأن القاعدة الفقهية تصلح بذاتها
دليلاً، ولكن تعينك على أن تعريف نظائر الواقعة المستجدة من الفروع الفقهية التي تعرفها،
وحينئذ يمكنك أن تطبق على هذه الواقعة الجديدة مثل ما طبقه الفقهاء من الأدلة ومن طرائق
الاستدلال حين طبقوا ذلك على واقعة قديمة، فأنا لا أستدل بالقاعدة الفقهية، ولكن
تعينني القاعدة على إلحاق هذه الحادثة بما يشبهها، وحينئذ أطبق عليها من الاستدلال
ما طبق على هذا الفرع الأصلي.
أيضا من فوائد القواعد الفقهية:
إمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة جداً، وذلك في أقرب وقت. هل تعرفون حجم الفروع
الفقهية الموجودة في المدونة الفقهية الكبرى؟ شيء كبير جدا. ولو أخدت مذهباً واحداً
من المذاهب ونظرت في بعض كتبه الكبرى ستجد عشرات الآلاف من الفروع الفقهية؛ فكيف إذا
نظرت في كتب أخرى؟ كيف إذا نظرت في كتب المذاهب كلها؟ كيف إذا نظرت في أقوال السلف
والآثار المنقولة عن الفقهاء المتقدمين قبل وضع المذاهب .. إلى آخر ذلك. فالفروع
كثيرة، ومن أراد أن يحفظ هذه الفروع فإن ذلك يستعصي عليه؛ لا شك أنه يحتاج إلى حفظ
مجموعة كبيرة منها، ولكن يمكنه الإحاطة بها إجمالا عن طريق القواعد الفقهية.
مثلاً: قاعدة "المشقة
تجلب التيسير". قاعدة إجمالية يدخل تحتها ما لا يحصى من الفروع، فكثير من
الفروع ربما لم تحفظه من كلام الفقهاء، ولكن تقول هذا يطبق عليه قاعدة المشقة تجلب
التيسير، فإذا راجعت قضية وجدت أنه فعلا الفقهاء طبقوا عليه هذه القاعدة إما بلفظها
أو بلفظ آخر. فأنت تحيط بالقواعد ثم تحيط بهذه القواعد بطريقة. ليس فيها تشويش ولا
اضطراب. وهذا من أعظم الإشكالات التي تقع لبعض المبتدئين أو حتى غيرهم من
المعاصرين حين تجده يعرف فروعاً فقهية كثيرة لكن بين بعض هذه الفروع شيء من
التناقض وهو لا يشعر أصلاً بوجود هذا التناقض، ولم لا يشعر به؟ لأن ضبطه لهذه
القواعد هو ضبط تجميع فقط. يحفظ هذه الفروع كما هي، لكنه لم يلتفت إلى الضوابط
الجامعة والقواعد التي تعين على الإحاطة بهذه الفروع الفقهية، فالقواعد تعينك على
ترتيب ذهنك الفقهي، بحيث لا تعزب عنه بعض المسائل ولا تتناقض الفروع عليك.
القواعد الفقهية مهمة في الفقه
عظيمة النفع، وبقدر إحاطة الفقيه بهذه القواعد يعظم قدره، وتكبر مرتبته الفقهية.
أما الذي إذا جاءه الفرع الفقهي فإنه يخرج الفرع بمناسبة جزئية دون نظر إلى القواعد
الفقهية، النتيجة الحتمية أن الفروع تتناقض عليه وتختلط، وكما لا يخفى الجزئيات لا
تتناهى. فإذن من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ كثير من الجزئيات أو أكثر
الجزئيات لأنها مدرجة تحت الكلية.
نعيد التذكير بها:
دراسة الفروع والجزئيات الفقهية يكاد يكون أمراً مستحيلاً، بينما حين يدرس الطالب
قاعدة كلية تطبق على فروع كثيرة لا حصر لها فإنه حين يتذكر هذه القاعدة يستحضر
معها كل المسائل الداخلة تحتها وكل الفروع المندرجة تحتها.
أيضاً
لو فرضنا تحقيق هذه الفروع الفقهية فإنها سريعة النسيان، وتحتاج دائما إلى الرجوع
إليها في كل مرة، وهذا يحوجك إلى جهد وإلى مشقة وإلى حرج، أما القواعد الفقهية فهي
محصورة في عددها يمكن حفظها بسهولة، وبالتالي فهي أبعد عن النسيان خاصة أنها قد
صيغت بعبارات جامعة سهلة الاستحضار، ولن اخوض في قضية صياغة القواعد لأن هذا يدخل فيما
يسمى بالتقعيد الفقهي، والذي يسعى إلى العبارة الجامعة المانعة. كـ: "العادة
محكمة". "المشقة تجلب التيسير". "الأمور بمقاصدها". "اليقين
لا يزول بالشك". "الضرر يزال". هذا مأخوذ من حديث: "لا ضرر
ولا ضرار" وهو أيضا حديث جامع.
هذا في القواعد الفقهية
الكبرى، ويمكن أن ننتقل إلى القواعد التي هي أخص. فيمكن أن يعبَر عن قضية الضرر بـ
"يُتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام". قاعدة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"
فهذه القواعد مصوغة بشكل يمكن استحضاره بسهولة فلا ينسى كما تنسى الفروع الفقهية.
أيضاً
كما ذكرت آنفاً الجزئيات الفقهية يمكن أن يتعارض ظاهرها، ويمكن أن يظهر عليها التناقض
فيؤدي هذا بالطالب إلى شيء من الخلط والارتباك. بخلاف القاعدة الفقهية فإنها تضبط
المسائل الفقهية ضبطا حسنا وترد الفروع إلى أصولها وتسهل على الطالب أن يدركها
ويفهمها.
ثم القواعد: تستعمل
بسهولة عند غير المتخصصين في الشريعة. فأرباب القانون حين يريدون معرفة أحكام
الشريعة يصعب عليهم فليست لهم هذه المقدمات الفقهية التي تعينهم على التعامل مع كتب
الفقه، لا يمكن أن تقول له ادرس المتون الفقهية وابدأ بمقدمة صغيرة. هذا سيأخذ منه
سنوات، وهو يريد معرفة أحكام الشريعة إجمالاً مثلا يريد نظرية العقد في الفقه
الاسلامي كيف هي، ما القواعد الإجمالية التي تحكم هذه النظرية نظرية العقد في
الفقه حينئذ لا تأتي بمتن أو كتاب الفقه، بل تأتي بالقواعد الفقهية التي يمكن
تطبيقها في مجال العقود، أو في مجال المعاملات المالية، أو الأسرة في الإسلام هنالك
قواعد حاكمة في مجال الأسرة، هم عادة يمثلون بأرباب القانون لكن يمكن أن يطبق هذا
في مجالات أخرى وتعين القواعد الفقهية غير المتخصصين على الاستفادة من هذه
القواعد. ولذلك نحن يمكن أن نستعملها في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى،
ويمكن أن يفهم عنها الكثيرون من غير المتخصصين في الفقه.
أيضاً
دراسة القواعد الفقهية تعين على تنمية الملكة الفقهية، فتسهل هذه القواعد على طالبها
وعلى من يدرسها أن يصبح لديه ملكة راسخة في مجال الفقه، بخلاف ما لو اكتفى بحظ الفروع،
وهذا شيء مشاهد عند كثير من الجامدين على فقه الفروع. تجده يحفظ كثيرة جدا لكن
ليست عنده المكنة، ليست عنده الدُربة، ليست عنده الملكة الفقهية.
أيضاً:
هذا يذكرني بقضية المقاصد. القواعد الكلية تعين على إدراك مقاصد الشريعة؛ لأن
مضامين القواعد الفقهية يعطينا تصوراً متكاملا عن المقاصد والغايات، يعني مثلاً قاعدة:
"الرخص لا تناط بالمعاصي"، أو قاعدة أخرى مهمة جداً وهي من قواعد
المصلحة: "تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة". قاعدة هائلة جدا تدخل
تحتها فروع كثيرة وهي تعينك على معرفة المقصد. ما مقصد الشرع في عمل الإمام أو ولي
الأمر وتصرفه على رعيته؟ المقصد هو تحصيل المصلحة. بطبيعة الحال انا لن أخوض في
معنى المصلحة وفي معنى المقاصد ونحو لأن ذلك سيخرج بنا كثيراً عن مرادنا، لكن
المقصود هو أن هذه القواعد الكبرى تعين على ضبط المقاصد.
هذه بعض الفوائد التي
تعيننا على معرفة أهمية القواعد الفقهية.
سنحاول فيما تبقى أن نذكر
بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالقواعد الفقهية قبل أن نخصص المحاضرة المقبلة بإذن
الله عز وجل للحديث التفصيلي عن القواعد الفقهية التي يمكن تطبيقها على مجال
الدعوة إلى الله عز وجل.
فمن ضمن الأشياء التي يمكن
أن نتحدث عنها بخصوص القواعد الفقهية:
أن الناظر إلى تاريخ التدوين
في القواعد الفقهية يرى أن حين استقل كل مذهب من المذاهب الفقهية بمنهجه الخاص بالأحكام
الشرعية انطلاقاً من مجموعة من الأصول فقد برزت مجموعة من القواعد:
أولاً:
برزت قواعد الاجتهاد وقواعد الاستنباط، وهي الطرق التي يعتمد عليها المجتهد
لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذه القواعد التي تسمى قواعد علم
أصول الفقه.
ثم ظهرت قواعد التخريج التي
وضعها العلماء لرواية الأحاديث ولضبط الروايات والحكم على الأسانيد ونحو ذلك. هذا
هو علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث.
ثم هنالك أيضاً قواعد خاصة
بالأحكام، وهو القواعد التي صاغها العلماء خاصة من أرباب المذاهب الفقهية المتبوعة
لجمع الأحكام المتشابهة والمسائل المتناظرة مع بيان أوجه الشبه فيما بينها، أو وجه
التفريق فيما بينها. وكنت قد ذكرت آنفًا بأن من أسماء علم القواعد الفقهية علم
الاشباه والنظائر، ولكن هناك فن آخر هو فن الفروق، فكما أن الفقيه يحرص على الجمع
بين المتشابهات فإنه يحرص كذلك على التفريق بين المتفرقات، وتطبيق هذا في مجال
الدعوة إلى الله كما سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى مهم جدًا على اعتبار أن كثيرًا
من الفتاوى المتسرعة أو الشاذة التي نراها في عصرنا هذا بخصوص الدعوة إلى الله عز
وجل -إما من جهة التشديد أو جهة التميع- مبني على جمع بين متفرقات، أو العكس تفريق
بين متماثلات، فمن أتقن فن الجمع بين ما يمكن الجمع بينه والتفريق بين ما يجب
التفريق فيه ستسهل عليه أمور كثيرة في مجال التأصيل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
أيضاً مما نستقيده من
التقسيم الذي ذكرته لكم آنفًا: أن هناك قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، أما القواعد
المتعلقة بالأحاديث فهي خارجة عن حديثنا لأنها تهتم بالرواية لا بالدراية
والاستنباط والفهم، فالذي يهمنا هو التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية،
فالقاعدة الأصولية هي قواعد الأحكام التي تنشأ من دلالات الألفاظ العربية، وما
يعرض لتلك الألفاظ من ترجيح فيما بينها أو من عوارض ذاتية، كونها من قبيل المنطوق
والمفهوم أو من قبيل العام والخاص أو نحو ذلك، أو ما يدخل عليها من نسخ أو أشبه
ذلك. هذه هي القواعد الأصولية.
إذا قلت لكم: "المنطوق
مقدم على المفهوم" هذه قاعدة أصولية. لو قلت: "الأمر يفيد لوجوب"
أو "حقيقة في الوجوب" "النهي يفيد التحريم"، "النهي
يقتضي الفساد" "العام يبقي على عمومه إلى أن يرد المخصص". هذه كلها
تسمى قواعد أصولية.
القواعد الأصولية مرتبطة بدلالات
الألفاظ، وهي قواعد تفيد المجتهد في عملية استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها
الجزئية.
أما القواعد الفقهية فهي
قواعد تشمل على ما لا يحصى من أسرار الشريعة وحِكمها، وهي قواعد غير مذكورة في علم
أصول الفقه، وهي القواعد التي يعني كتب فيها كتب كثيرة في مجال علم خاص يسمى علم
القواعد الفقهية، من أوائل ما أُلف في علم القواعد الفقهية: كتاب تأسيس النظر لأبي
زيد الدبوسي الحنفي الذي توفي سنة ٤٣٠، هذا الكتاب من أوائل الكتب التي ذكرت مجموعة
من الضوابط الفقهية والقواعد الكلية. ثم بعد ذلك جاء جماعة من المؤلفين في المذاهب
المختلفة فكتبوا العديد من الكتب في القواعد، لكن من أهم ما يجب أن نعرفه هو أن الترتيب
النظري بين الأصول والفقه والقواعد الفقهية هو أن يقال: إن الأصول هي الأساس،
ويبنى عليها الفقه، وتبنى على الفقه القواعد الفقهية. هذا الترتيب النظري.
معناه:
نضع أصول الفقه أولاً، وكما يدل على ذلك، فأصول الفقه هي بالنسبة للفقه هي أصول
له. والأصل ما يبني عليه غيره، فإذًا الفقه مبني على أصول الفقه. وبالتالي نجد
فروعاً فقهية كثيرة جدًا في العبادات والمعاملات ونحو ذلك.
يأتي بعد ذلك المُقعِّد
الذي يريد تقعيد القاعدة الفقهية، فيجمع شتات هذه الفروع الفقهية، بالطريقة التي
ذكرنا بالتفريق بين المتفرقات والجمع المتناظرات والمتشابهات، فيجمع من ذلك مجموعة
من القواعد ويصوغها صياغة حسنة، فيأتي علم القواعد الفقهية.
إذًا:
الترتيب هو هذا القواعد الفقهية مبنية على الفقه، والفقه مبني على الأصول، لكن
بطبيعة الحال هذا ترتيب نظري، وإلا فحقيقة الأمر أن هذه العلوم كلها متزامنة في
واقع الحال، لم يجلس العلماء قرنًا أو قرنين أو قروناً وهم يؤصلون أصول الفقه، ثم
قالوا انتهينا من أصول الفقه نبدأ بالفقه .. لا. في الوقت نفسه الأئمة يقعدون
قواعد الأصول ويستنبطون الأحكام الفقهية ويقعدون قواعد الفقه، فهو شيء واحد في
ترتيب زمني واحد.
على كل حال أُلفت كتب كثيرة
جدًا في علم القواعد الفقهية من أشهرها:
- كتاب قواعد الأحكام للعز ابن
عبد السلام وهو من أئمة الشافعة المعروفين.
- من أئمة المالكين الإمام
القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي الذي له الكتاب المعروف الفروق
وأنوار البروق في أنواع الفروق.
- هنالك أيضا من الكتب
المشهورة الأشباه النظائر لجماعة من المؤلفين. الحموي ولابن الوكيل والشافعي
والسيوطي.
- هنالك أيضاً في المذهب
المالكي كتاب القواعد للمقري.
- وأيضًا كتاب الونشريسي في
القواعد الفقهية.
- هنالك أيضا كتاب المنثور
في ترتيب القواعد الفقهية للزركشي هذا شافعي.
- هناك قواعد لابن رجب
الحنبلي وهي مطبوعة ومتداولة وهي عجيبة جدًا، وفيها فوائد كثيرة اسمها تقرير
القواعد.
- هنالك منظومات كالمنظومة
المتداولة عند المالكية التي شرحها الإمام المَنجُور وأكملها الميارة.
على كل حال الوقت لن يكفينا
لذلك من الأفضل حتى تكون المحاضرة الثانية متكاملة ومرتبة ترتيبًا حسنًا أن نترك
تطبيق القواعد الفقهية الخمس الكبرى على مجال الدعوة إلى الله عز وجل إلى المحاضرة
الثانية.









اكتب مراجعة عامة